ابراهيم جادالله

فيوم أطل عبدالناصر علينا ، كان بهيا وصاحب حظ خارق فى الزعامة: أسعفه عصره، فتطابق مع طبائعه. ومن العصر والطبائع استمد كاريزماه ، فرأينا فى عينه التماعة القوة والإقتناع مما جعل من حبه أمرا مرغوبا ، ومن توسل وجهه رجاء مديدا.
وبعيد طلته الأولى ، استقر عبد الناصر فى وجداننا حاكما صادقا، مهموما، يضحى ويسهر ويرعى، لايبتغى غرضا لنفسه، يتلقى شخصيا شكاوى البسطاء وتظلماتهم ، يتابعها ويحلها بقرار. فكان هؤلاء ينتظرونه على قارعة الطريق، ليسلموه واحدة من رسائل الشكوى،. فهم كانوا يعتقدون، عن حق ربما، أنه مهموم بمهموم،. لذلك فالمعارض الذى عارضه دخل السجن، وخرج ، وخرج واقعا فى حبه. والأقل بساطة من هؤلاء السجناء عين وزيرا فى إحدى حكوماته، أو مديرا لأحد مؤسساته.
هكذا مر مايقارب العقدين وعبدالناصر الحاكم يرعى ويحنو ثم يقسو ويبعد . نحبه كما يحب الأب: يمكنه أن يفعل بنا ما يشاء، لكنه يبقى والدنا، لانستطيع غير الولاء له، هو صاحب الرحمة والقرار فى آن.
وبعدما خاب ظننا فى حزيران(يونيو) 1967 ، كان شعوره بالأبوة قد خفت ، فقدم فى لحظة تشبه الضعف استقالته، معلنا تخليه عن رعايته لنا وتركنا لمصيرنا.
وربما كانت لحظة الضعف هذه فرصتنا الوحيدة لنجنب أنفسنا ما سوف نحرم منه نهائيا: أى تنحى أو استقالة رئيسنا، أو تسليمه السلطة سلميا لغيره، فى حياته، وليس بعد وفاته. لكننا أبينا وفاء له وخوفا ربما من الرشد ومن مسئووليات الحرية. فخرجنا بالآلاف فى ليالى يونية1967 الدامسة ، نتوسله أن يبقى ، معلنين بوضوح خوفنا من اليتم والتخلى. رفضنا استقالته الناتجة عن إخفاقه الإضطرارى ، فاستجاب هو، وإن بقى مكسورا، ينقصه وهج الفتوة السابق.
لكنه كان حيا، وما من أب ولا رئيس لنا سواه ...
منذ تلك اللحظة صلبنا نظاما فى التداول السياسى غدا ثابتا ومستقرا: لانعرف بموجب رئيسا عاد إلى صفوف المواطنة العادية ، لانعرف رئيسا إلى مدى الحياة... إنهم كالآباء باقون بحكم الطبيعة، وليس بقانون الاجتماع.
نحن مسئولون عن تصليب نظام كهذا، نظام الرئاسة الأبوية التى لا فكاك منها إلا بعد الموت، ونحن بالتالى مسئولون عن انعكاس هذا النظام على رؤيتنا لعبد الناصر وطريقة إحساسنا به .
فنحن فى ذكراه، المكررة دوما، نقف بازاء أب _رئيس متوف، ضد أب أتى بعده ،أوآخر مازال على قيد الحياة ، لكننا لم نعد نقدر عليه منذ أن تخلينا عن تلك القدرة فى إحدى ليالى حريزان الدامسة، والتى كان لها ظرفها ،ولم تكن تليق إلا برجل كعبد الناصر ، أو بزعيم غيره ، مهما بدا منكسرا وضعيفا .
ففى مديح الناصرية ، هناك غالبا ما هو مضمر ضد الرئاسة الراهنة، وعلنى صريح ضد الذيول التى سبقتها . هناك مديح يشبه الشكوى المرفوعة إلى الأب المؤسس ضد لأب الراهن. فى هذا المديح تذكر طباعه وأحلامه ومشروعه فى ما يشبه حلقات الذكر الصوفية ... احياء لصاحب الطريقة التى لم تؤثر السنون ، ولن تؤثر فى صحتها وإنما زادتها توكيدا.
هكذا تحضر وتستقبل الأزمات التى نعرفها جميعنا، وكذلك العبارات والطقوس واللهجات. وكل هذه ليست من صنيع ناصريين فحسب، بل يمكن أيا من الوجوه أو الشخصيات العامة رعايتها أو الإفصاح عنها فى المنابر المخصصة لها: تطل علينا هذه الشخصيات وقد سحرت نفسها عند كلامها عنه، فتلبستها شخصيته . بعدما كانت ممعنة فى نقضه أو نسيانه.
وقد يدوم هذا التلبس لحظة أو العمر كله، بحسب كل شخصية . لكنه فى الحالين، يشبه واضع اقنعة النزاهة والتضحية والقوة على الوجوه كلها : أقنعة، هى كالتبرك بالأضرحة ، تغفر خطايا حاملها ، فيتطهر هو بإذاعة محاسن البطل
النبيل النظيف الشجاع .
ولدى غير الباحثين عن
 غفران ، بل دائما عن إلهام وأبوة ، يبدو تذكر عبدالناصر حنينا موجعا ليس إلا . فكم من امرىء قال له أو لنفسه إنه يحب عبدالناصر ،بالرغم من((تحفظاته)) ، وكم من امرىء يصف زمان عبدالناصرب((الجميل)) ، ويبكى ، أو يكاد، لدى سماع أغانيه الوطنية ويتلذذ بعذاب الفقدان فيغنى مع عبدالحليم وأم كلثوم للوطن والكرامة والحرية ، والغصة تضيق خناقه.
غفران ، بل دائما عن إلهام وأبوة ، يبدو تذكر عبدالناصر حنينا موجعا ليس إلا . فكم من امرىء قال له أو لنفسه إنه يحب عبدالناصر ،بالرغم من((تحفظاته)) ، وكم من امرىء يصف زمان عبدالناصرب((الجميل)) ، ويبكى ، أو يكاد، لدى سماع أغانيه الوطنية ويتلذذ بعذاب الفقدان فيغنى مع عبدالحليم وأم كلثوم للوطن والكرامة والحرية ، والغصة تضيق خناقه.لكن المناسبة تستعيد حماسا بات ينقصه فى حياته العادية، بعيدا عن هذه الأغانى: حماسا غريبا وسط الخراب المديد، حماسا تعلم أنه لم يبق من نسخته الأصلية غير كابوس الحاضر...أو((الواقع)) الذى يتسم دائما ب((البشاعة)) .
هكذا تضاءل قدرة العقل على التدبير وتختلط الأمور، لتعود فتمر ذكرى عبدالناصر عند محبيه ، من دون تبدل يذكر، غير الاستجارة به بعيد ذلك بشهرين أو ثلاثة.
هكذا تتغذى قلة معرفتنا بعد الناصر، قلة موضوعيتنا حياله، بأشياء أخرى موزعة هنا وهناك: فيسمى المدعى العام((اشتراكيا)) ويوصف الفن الكمى الهابط ب((الجماهيرى)) وتقسم فئات المرشحين للانتخابات التشريعية إلى ((عمال))و((فلاحين))و((فئات))، وتزدهر شعبية بعض كبار المسئولون لمجرد إحيائهم اللهجة الناصرية . ثم هناك الحب الديماغوجى للشعب ، تتخلله فكرة ما للعدالة الاجتماعية لا ترى تجسيدا لها فى غير ((البقشيش)).
كلها إشارات موزعة هنا وهناك ، تحث على ركود العقل فى محاولته فهم ما حصل تماما حوله ، أو ما هو حاصل الآن...نوع من الضبابية والتشوش والكثير من المتاهات ترعاها الشرعية العسكرية التى أسسها عبدالناصر. لذلك لادعوة عنه ولا عنها مهما تبدلت وظائف الدولة التى قامت على أساسها.
لماذا نحتاج إلى الموضوعية فى معرفتنا بعبد الناصر وتصورنا له؟ لكى نصحح الخطأ التاريخى الذى ارتكبناه تجاه أنفسنا عندما طالبناه بالعودة عن التنحى إثر الهزيمة التى جرنا إليها ، نحن أولاده، ولسنا أولاد غيره فى الحقيقة ، وهو الخطأ الذى مانزال حتى الآن ندفع ثمنه، والذى يحصرنا فى حلقات كلها مغلقة، من التساؤل حول وجودنا فى هذا العالم.
كيف نخرج الى هذه الموضوعية؟
بأن نصدق أن عبدالناصر مات: كأب على الأقل، طالما أننا لا نستطيع خلعه من الرئاسة وهو ميت. فهو لا يتفوق على آبائنا بشىء. إنه جزء من التاريخ، أو بالأحرى من عصر، نحتاج أن نفهمه لا أن نقدسه ، وإلا أضفنا إلى وجداننا عصرا((ذهبيا)) آخر نخاله عونا لنا على أيامنا السوداء، فيما هو ليس سوى فخ يجرنا إلى التأتأة والتعلثم ونصف الإدراك، فيمنعنا من بلوغ الرشد . والرشد مرحلة من عمرنا السياسى نحتاج إلى أن نتفوق عليها . إذ بات علينا أن نفهم أننا وحيدون فى هذا العالم : لا صديق لنا ولا أب ولا معسكرات...














.jpg)













































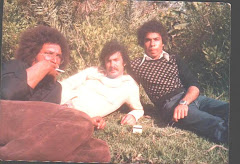













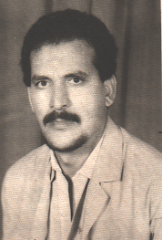









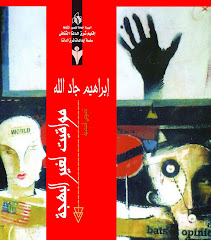

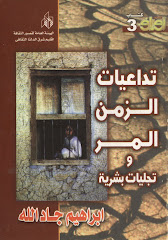









.png)









-001.jpg)










