
عن طنجة
المدينة الكونية
و
صديقى محمد شكرى
ابراهيم جادالله
صباح التاسع والعشرين من أكتوبر الرصاصي المطير عام 1988 م، وأنا ألملم تعبي المنهك من الرحلة الطويلة الشاقة، والأحلام الرمادية المنثورة في الضياع أمام " كونتر" الاستقبال، بنزل متواضع أرتاده دوماً حينما أصل لهذه المدينة. ومن تلك الردهة، ردهة الاستقبال الخافتة الإنارة والعتيقة الطراز بذلك المبنى القديم، وبالتحديد من زاوية شبه معتمة، استخدمتُ الهاتف العمومي بنزل "طنجة ماركوبولو" المطل بشرفاته الفسيحة الشرحة هذا الصباح، ويبدو أنها تلك اللحظة في هذا الكيان من المعمورة تودّع المسافرين وتستقبل القادمين في ميناء المدينة الكونية المتقاعدة من حطام زمن "الفلتات" التاريخية التي حباها القادر بأن تكون يوما ما ناراً على علم. لقد كانت كما قيل بأنها فلتة زمانها منذ أزمنة بعيدة حينما أصابتها الشهرة العالمية أكثر من ذي قبل، بل ومنذ بداية القرن العشرين أخذت لها شهرة أخرى ألا وهي إقامة الأدباء والموسيقين العالميين عندما أصبحت مدينة كونية وموقعاً استراتيجياً، كما حبتها الطبيعة أن تكون أقرب نقطة عبور للقارة الأوربية حيث يفصلها عن القارة الأفريقية مضيق جبل طارق الشامخ بسموه كلما التقطه البصر.
ها هي المدينة الممتدة من خلال حديقة النزل على مرمى حجر من ناظري تـُـفـْـشي لليوم عن مأربها ومبتغاها. لقد كان سمعي مركّزاً لحظتها في التقاط رنات جرس الهاتف المنزلي حتى انقطع نياطه، غير أنني في الحقيقة لم أحظ برد من الرقم09944442 الذي طلبته. وحينما لاحظ صديقي عبدالله مدير النزل والذي تربطني به معرفة سابقة أنني في ربكة من أمري بعد تلك المكالمة التي لم تتم، سألني إن كان في وسعه تقديم عون! نعم أجبته، وأنا أقولها بأسى أن الرقم الذي أطلبه لا يجيب، وحيث أن لدي حدساً مرهفاً، وإصراراً مكيناً، بأنني سأجد الجواب منه، لأنه من أبناء هذه المدينة، فلا تفوته شاردة إلا ويلتقطها ولا واردة إلا ويتلقفها، وتلك أسوقها من خلال تجاربي معه. كان جواب الصديق عبدالله بأنه بالطبع يعرف المعنيّ أين يقطن، لكنه لا يعرف رقم هاتفه المحمول، وهو مشغول طوال هذا اليوم بفوج من السواح الغربيين سيصلون النزل في الحال، غير أنه يعرف أقصر الطرق للوصول إليه. حيث نصحني بالذهاب الآن وفي الحال إلى فندق ومطعم يرتاده من أريد لقياه، وذلك المكان كما يؤكده صديقي عبدالله من أمكنته المفضلة، وهو في قلب المدينة، والسؤال عن بغيتي هناك، وربما سأجد الحلّ لمعضلتي، كما أكدها عبدالله بابتسامته اللطيفة. قلت له لا بأس، لكنني يجب أن أجلب من الغرفة ما جئت من أجله. لم يعلق على الأمر بشي غير أنه طلب مني مرافقته إلى البوابة الحديدية الخارجية من النزل، وهناك طلب من سائق الأجرة أن يأخذني لنزل ومطعم "رِدز"، المكان المنشود.
كانت عقارب الساعة في معصمي تشير حينها إلى التاسعة والنصف صباحاً، وكنت في أوج توقدي ونشاطي للقاء غير مرتقب مع أهم المفاتيح في هذه المدينة بعد غيبة عام كامل، وكان لا بد أن يتم هذا اللقاء في أول مهمة لي في طنجة. وأمام المكان المقصود ترجلت من عربة الأجرة وأنا أحمل همومي في حقيبة الظهر بعد عناء الوصول من مدينة الرباط بقطار ليل البارحة الطويل. وحينما وصلت المدينة بعد غيبات من استخدامي القطارات بمصر وقد حلت الباصات الايرانية محلها بالنسلة لى، وجدت محطة القطارات الرئيسة خارج المدينة والتي كانت في سابق من الزمن قريبة من الميناء، وفي مواجهة النزل الذي أنوي القيام به عندما أصل لمدينة طنجة. ولشدة ازدحامها هذا الصباح بطلعاتها ونزلتها في هذه السويعات الباكرة، كان عليّ لقائى الذى من أجله جئت إلى هنا، على خير ما يرام، حيث كان هدفي من هذه الزيارة، هذه المرة إيصال ما معي من وصية أوصاني بها صديق عزيز. من هنا حملتها معي من مدينة القاهرة وبقيتْ في حقيبتي بفترة طويلة وها هي تصل اليوم لمن طلبها مني في هذه المدينة. لقد كنت لحظتها - وأنا الراكب الوحيد في قلب سيارة الأجرة الصغيرة الخضراء والموشحة بخطين أصفرين من نزل ماركوبولو، والذي أصبح أكثر نزلائه من سائقي الشاحنات العابرة للمغرب من أوروبا عبر المدينة، وكأننا نشبه علب الهدايا- كنتُ في الكرسي الخلفي مكدساً في حدود حيز ضيق، ومُـتعِـب، وغير مريح، وهو يطلع بي مطالع المدينة ومنازلها ومنعرجاتها دون مبالاة بعقبات الطريق، وكأننا في سباق مرثوني مع موج، بحرُهُ من البشر الهائج في هذه الساعات المطيرة، حيث يكثر في مداخل الشوارع ومخارجها كثافة البشر وتكدس البضائع وضجيج العربات، بل كما يراودني الانطباع أن سكانها أكثر هيجاناً من بحرها. ويبدو أنها ساعات الذروة، حيث الحركة والازدحام على أشده في صباح طنجة المدينة.
وأمام بوابة نزل ومطعم "ردز" في قلب المدينة كان يقف فتى يرتدي ملابس كالتي يرتديها ندل المطاعم المطلة على البحر، يعقد مريولة خضراء طويلة على خصره، ويبتسم، حيث يرشدني إلى مدخل المكان، وحينما أشار إلى الطاولة التي عليّ أن انزوي بها -ريثما يحضر لي قائمة الطعام- أخبرته بأنني ما جئت من أجل الأكل، لكن لا ضير من الفطائر مع الأتاي، الشاي المغربي، ريثما يحضر من أنتظره. وبعد أن حدّق في سحنتي وتأمل مظهري قال لي بأنني أحمل وجهاً مألوفاً، وأنه ربما قد قابلني في السابق، لكنه لا يتذكر متى وأين تم ذلك اللقاء. على أية حال ربما كان يجاملني في الحديث، لكنه سألني عن الشخص الذي أنتظره في هذه اللحظات الصباحية؟ وقد أجبته هكذا وببراءة ريفيّ عندما نطقتها" باه شكري" ممتدة من فمي كلحن في الحياة. غير أن النادل اختفى وأخذ سمعي يلتقط جملته "أنه بدري. وشكري لا يصحو في هذا الوقت" وبعد برهة سمعت صوتاً يأتي من ورائي، و ترحيباً حاراً يصل إلى مسامعي من صاحب المكان، مشيراً للنادل سي محمد بأنني السندباد عليُّ الزمان، اجلب له ما يشاء. كان صاحب النزل صديقاً شهماً وإنساناً ودوداً بمعنى الصفات الحميدة، عرفته وجربت التعامل معه مرات حينما ترددت على مدينة طنجة، وزادت رحابة تلك المعرفة والصداقة له أكثر حينما أخبرته عن سبب هذه الزيارة، وحفنة التراب التي أحملها معي معلقة في رقبتي وصية، وتشوقي للقاء محمد شكري بهذه السرعة. غير أنه أخذ يضغط على أزرار هاتفه النقال وهو يبتسم ويهز برأسه إلى أن وصل إلى بغيته، طالباً مني أن أتصل من هاتف النزل بالرقم 061878870 ، حيث كان على الخط صوته الشاحب بالشيخوخة ذو الحس الطفولي ينهمر فرحاً، وأنا أعرفه بآدميتي، منتصراً لهذه الرحلة وأنا أؤكـّد له وصول الـ" فيمس كراوس" سالمة وغانمة، أحملها بيدي، حيث كانت في السابق غالباً ما تنطفيءُ في أفواه وبراثن الأصدقاء منذ أول ليلة أصل لها في هذا القطر العزيز.
- أنت يا مسخوط - قالها بحس قوي- متى وصلت! أين أنت؟ حالاً سأكون معك بعد أن أخبرته بوجودي في فندق ومطعم ردز، مكان جلساته المفضل في السنوات الأخيرة في طنجة، لقد قلت له أن لا يستعجل المجيء، فأنا ما زلت في أول نهاري ويمكنني أن أقرأ في كتاب أحمله معي، غير أنه قال لي "نصف ساعة وأكون معك".
كان وجهه متهللاً بالفرح حينما دلف علينا قاعة الشراب، وحينما عانقته ومددتُ له بهديته التي عادة ما كانت تصادر من قبل رسام الليل وشاعر النهارات في مدينة الرباط إن كان في المدينة قبل مغادرتي متجهاً إلى طنجة الخيانة. ثم ما إن ناولته مقالة كتبتها عن حكاياتي ، وحفنة تراب من قبر المطربة المرحومة أسمهان، والذي أوصاني به من القاهرة، حتى أخذ يحدق في المقالة طويلاً ويقرأ بعضاً من فقراتها بصوت عالٍ يسمعه كلّ من كان بالمكان. ثم عانقني من جديد وهو يقول: " يا مسخوط كنت أمزح بخصوص التراب!". وأبلغته أنني أوصلت سلامه الحار للأديب فاروق عبد القادر حينما التقيت به مساء يوم أحد في مقهى الحميدية بوسط القاهرة. كان محمد شكري لحظتها يحمل فرحاً تلمحه في محياه من اللحظة الأولى لكن في واقع الأمر ما هو إلا فرح الشيخوخة والعائدة من أمكنة قديمة ومع ذلك كانت الحالات التي هو عليها تحمل في بسطتها الاقتراب منه دون عُـقـَد، بل ويقاسمك فرحها البسيط عن أحواله مع الحياة ووهج صخبه نحو الحياة، و الاستمرار في هذه المدينة برغم سخطه على ما آل عليه حالها، وحال البشر بها. وكان بذلك يريد أن يمرر به لحظة صفاء مع صديق قادم من بعيد، يحمل همومه ومعاناته بعد ما أخبرته عن الحلم القصير الذي عشته عندما انقلبت الأحلام إلى رماد وها أنا أعود من حيث أدراجي مفعماً بالخيبات الكبار. هكذا كان شعوري به وهو يطلب كأساً من "بيرنو" ويضع على الكرسي المجاور مجموعة نسخ من الإصدار السابع من الخبز الحافي وقـّعها في الحال كإهداء للأصدقاء عرفهم من كتاباتهم ، ويطلب مني إيصالها لهم أثناء عودتي للوطن، وحينما تطفلت على تلك الأسماء، دُهشت لمتابعته كُـتـّاباً وكاتبات جدد ينتمون لجنس فن كتابة القصة القصيرة في وطني، والتي لسوء الحظ لم أعرفها حين ذاك
لقد كان حينها ينتقل بالحديث مع حركة يده، و يخبرني عن إرشادات الأطباء في تقنين حالات التدخين حينما استل من جيب معطفه علبتي سجائر لماركتين واحدة محلية والأخرى أجنبية كي يقلل من التدخين حسب وجهة نظره. كان محمد شكري في أوج تجلياته تلك اللحظة. خاصة وأن كثيرين من الاصدقاء يعرفون قصة حفنة التراب التى طلبها شكري والتي عليّ إيصالها له من قبر المطربة أسمهان. كان عليه أن يخبرني بذهابه إلى أسبانيا حيث سيجري مقابلة تلفزيونية لإحدى محطات تلفزة مدريد، وسوف يبقى ثلاثة ليالٍ هناك، وقد وعدني بأنه سوف يذكر قصتي والخوف من أن تكون محملة بالميكروبات وأنا أعبر بتراب المرحومة ثلاث مطارات عربية لكن محمد شكري لم يكن يعلم بأنه لا يهمني هذا الأمر بقدر ما يهمني مصداقية الوصية التي أوصاني بها من الـقاهرة، وهكذا فعلت حينما نفذتُ وعدى بالذهاب إلى مقابر البساتين وجلبِ حفنة من التراب من تحت تربة مقابر آل الأطرش، وبالذات من قبر المطربة أسمهان، والتي يرقد بجوارها أخوها الفنان فريد الأطرش. كما ذهبت إلى الناقد فاروق عبد القادر حال جلوسه في مقهاه المفضل "سوق الحميدية" كل يوم أحد من كل اسبوع في وسط القاهرة.
كنت أحرص في الحقيقة على إيجاد وقت أقتنص فيه أنفاسي ، وكأنها دعوة من محمد شكري يوقتها لي بالتريث والمكوث في هذه المحطة وباغتنام فرصة الاسترخاء من عناء السفر والترحالات هنا في طنجة أوفي مكان آخر من هذه البلاد، لكنه بعد برهة نصحني بالذهاب والانزواء في سهول ومروج "شوف الشاون" لعلي أشفي ما بي من غليل. ثم زودني برقم هاتف لمنزل، يقول أن كل أصدقائه يكترون منه غرف منام حينما يذهبون للشمال، وهو بالفعل مكان للراحة والاستجمام. ونصحني بالابتعاد عن فنانة تشكيلية من بلجيكا تقطن تلك الدار، و تدعى " فيكي" شبه معتوهة كما رأيتها بعد ذلك، ولا أعرف لليوم حظوظي والغرائبيات التي تحدث لي مع الفنانات التشكيليات في هذا الكون. لم أدرك في تلك الليلة من عام 1988م - حينما التقيته في نفس هذا المكان قادماً من مدينة سبتة بغية تجديد إقامتي في المغرب وماراً مروراً سريعاً علي محمد شكري- القراءة التي قرأني بها، إلا بعد صدور كتابى "المسرح العربى والتحدى الحضارى" وهو يُعَرِّفني بثلة من الأصدقاء كانوا يشاركوننا الطاولة بأنني سوف أكتب رواية الرحلة عن الناس والتقاطعات الثقافية والأمكنة. لقد جمعتني تلك الأمسية بروائي من شمال المغرب ، كان إنساناً رائعاً وكنت قد قرأت له رواية لا أذكرها الآن وتحدثنا عن مدينة طنجة ومدينة تطوان ، وعن الأشياء الجميلة في هذا الكون، تلك الأشياء التي تجلى فيها " باه شكري" حتى الهزيع الأخير من الليل رغم وصايا الأطباء بالخلود للراحة مبكراً والذهاب للسرير. وأذكر ليلتها أنه كلما أحس بوجع أو حتى من استشعر ذلك لمن كان معه في الجلسة فإنه يستخرج من حقيبته اليدوية دواء لذلك الوجع. إنه صيدلية متنقلة، خاصة أدوية عاهات الحوامض والأمغاص المعوية.
تعود علاقة لقائي بمحمد شكري بصدفة ظبطية وقدرية في عام سبعة وثمانين وتسعمائة وألف، حينما كنت أزور المغرب ذلك الصيف، قادماً من مدينة تونس بغية هدف بعينه لتلك الرحلة بعيداً عن لقاءات الأدباء، ومنتديات الثقافة. وكان السؤال المحيّر الذي يزعجني ويراودني هو ذلك الاستفزاز الواضح والصريح عن كيانات المدن ومواقعها الطبيعية على هذا الأديم.
نعم ، ثمة سؤال كنت أطرحه على نفسي في تلك الفترة حول تمحور الأمكنة وتشابه بيئاتها الأساسية في تكوين كيانها وقيامها بقوة في فترات من عمر حضارة الإنسان على هذه الأرض، في كل شئ، رغم بعدها عن بعضها البعض جغرافياً ومكانياً وزمانياً. ، وكان علي أن أعد مشروعا عن حالة كهذه الحالات، ألا وهي حالة الأمكنة في محيط حضاري طبيعي يدعى بتشابه تضاريس المكان، مؤثراً ومتأثراً في حضارات البحر الأبيض المتوسط، يؤجل الشك في ذاتي عن دقة الصحّ وسر حصيلة نسبية آينشتاين حول سبرمة تلك الأمكنة وخلودها في الوجود، لاعتقادي بأنها زائلة بحكم ظروف الطبيعة، وهي ليست أعمق خلوداً إلا إذا تلبستها المثيولوجيا وأسطرتها. وكانت أجوبة تلك الغوامض بالنسبة لي تتمحور في ثلاث مدن تقع على ذلك الحوض، وعليّ بزيارتها كي يَـثـْبـُتَ إيماني بتلك النظرية. هكذا جزمتُ بهذا التشابه في فتواي فيما بينها، وأعني بها تلك المدن الثلاث: مدينة الإسكندرية، ومدينة اللاذقية، ومدينة طنجة. وكل ذلك يصب في معنى التوأمة الجينية بالطبيعة تحديداً، وتشمل سمة علم الحضارات الإنسانية الخاصة بها، وحددت هدفي في نسغ المقومات المشتركة من معرفة شاملة في جغرافيا بشرية منتجة لكيان حضاري مازالت شواهدها حاضرة عبر الزمن، وهي ذات قاسم مشترك في نمط حياتها وإنتاجها الحضاري وكان ذلك حصراً على مدن بحرية، سادتـْها الحضارات المتعاقبة وتمسّ بحثي، الذى لازلن لحد الان آسفا على عدم استكماله ، ولا أدرؤى لماذا؟
كنتُ في ذلك الصيف أزور مدينة طنجة بحجة ذلك البحث واكتشاف غوابرنا الحضارية في تلك الثغور والتي ودعتْ واستقبلت الفاتحين والغزاة والعابرين والعائدين. وبعد يومين من وصلي لها شدني ليلها أكثر من نهارها، وكنت لا أنام فيها الليل، أتسكع في أزقتها وشوارعها وحوانيتها، أسبر وأقرأ الصور وأسترق السمع وتتحول ذاكرتي لمستودع ضخم وكبير لكل شيء أراه وأشاهده أو أسمعه في ليلها. لقد كانت تغمرني استرخاءات أشعة الشمس التي تتسرب من نافذة الغرفة في الدار التي اكتريتها بالنوم صباحاً وحتى الظهيرة. كنت أقطن في حي القصبة، استضافنى صديق بدارة صغيرة، هندستها المعمارية الداخلية على الطراز الأندلسي الفريد، مريحة وخلابة، وتطل على مضيق جبل طارق، الذي أراه شامخاً أمام بصري. وتذكرني تلك الدارة بذكريات عطرة قضيتها في أول زيارة قمت بها لمدينة طنجة. ولعل من أهم تلك الذكريات المنيرة في ذاكرتي أنه كلما نظرت من شرفات تلك الدار، الملتصقة بالشاطيء من الضفة الأخرى من معبر ذلك المضيق، يأتيني صدى صوت، في إصرار واستمرار للبقاء في هذه الحياة. وفي كل لحظة صفاء يأتي ذلك الصدى المائي من لجة البحر، وأنتشلها في أنفاسي، إنها الأندلس وعبق العطاء في عبارة قالها طارق بن زياد حينما وطأت قدمه اليابسة، لتكون بعد ذلك منبت نور لحضارة عربية خاطبة ومتزاوجة مع بقية الحضارات التي عاصرت دولة بني أمية في أسبانيا. وأما ما يميز تلك الدارة -غير موقعها بأعلى التلة- فهي أنها مفتوحة من داخلها على كل مرافقها، وتكثر بها النوافد على كل الجهات وتطلّ من أطراف التلة على المدينة، وليست ببعيدة عن السوق الداخلي، حيث تقترب مني وبصدق شخصيات الخبز الحافي، ومجنون الورد، والشطًار، والسوق الداخلي، والخيمة، في كل لحظة عشتها بتلك الدارة، خاصة وأنني اطلعت على ما يكتبه محمد شكري وغيرهم عن هذه المدينة في الدوريات وملاحق الثقافة والكتب وما يطاله يدي وبصري من منتج ثقافي عنها.
في ليلة من ليالي ذلك الصيف كنت أتريض على كورنيش المدينة قادماً من حي القصبة، وبالقرب من محطة القطارات وأنا في اتجاهي بمحاذاة الميناء، الطريق المؤدي إلى المدينة من جهة الشمال، استعد لليلة لقائي بفتاة كانت قد جرّت قدمي منذ هذا الصباح إلى أشياء خلابة في طنجة المدينة، وبغية الوصول إلى " نيغريسكو" وهي حانة ليلية ومطعم فاخر، كما وصفته لي سائحة سويدية صباح هذا اليوم، والتي أصبحت صديقة عندما التقيت بها صدفة، وهي في غاية السعادة مفسرة لي سر ذلك الحبور الذي قرأته في وجهها ذلك الصباح، باكتشافاتها الصغيرة في مدينة طنجة. وعندما تعرفنا على بعضنا البعض في حانوت صرف العملة الأجنبية بادرتني بالقول أنه لا يهمها كم صرفت من مالٍ في ذلك المكان، وأنها سوف تذهب هذا المساء وهي تدعوني على قهوة في أحد مقاهي شارع محمد الخامس بعمق المدينة كي نبرمج المساء والسهرة. وكوني مغرماً بليل طنجة فقد وافقتها على ذلك. لقد كانت "آنّا برسلـسْ" أول إنسان عرّفني بمحمد شكري، برغم عدم شهرته في المشرق العربي في ذلك الوقت، ما عدا المطلعين بشغف على النتاجاات الأدبية المختلفة وغير السائدة في تلك المرحلة. كانت آنا برسلس تعرف بأنه كاتب موهوب دون أن تخبرني بداية بذلك في المقهى، وحتى عن لقائهم ليلة البارحة، إلا بعد أن بردت أقداح القهـوة. لقد التقتْ به ليلة الأمس في حانة "نيغريسكو" ذلك هو الانطباع الأول الذي ورد إلى ذهني حينما عرفَ شكري بأني عربي من المشرق وتصطحبني فتاة شقراء من السويد في هذه البلاد. شيء مفاجئ بالنسبة لمحمد شكري أن يرى من الوهلة الأولى فلاحا مصريا مثلى مع شقراء الشعر ناصعة البياض، ذات عينين زرقاوين، يتحدثان عن أشياء مختلفة ما عهدها محمد شكري من أفواه" السواح" الشرقيين. لكنني وضحت له الأمر بأن "آنا برسلس" ليس كما يظنها، فهي نحاتة وخزفية تهتم بالإسلاميات، وأنا لست بترو دولار. وحينما انفعلت قليلاً، قلت له أن من عرّفني بك هو مجنون الورد. لقد جرّنا ذلك الحديث إلى عينات السياح القادمين من تخوم مدن الملح، وغياهب كثبان رمال الربع الخالي، وتلوّث ناس حقول النفط، وانقلاب ليالي طنجة، وعمارات الكيف التي توالدت كغابة أسمنت، حزمت عنق وأطراف المدينة الكزموبولتان، وغيرها من الأمور المقدسة، والتي لا يبخل بها محمد شكري بذكرها عن مدينته كما يقولها دوما: بأنه هو طنجة، وطنجة هي شكري، ويرددها كثيرا في سهراته، وبهزليته الفذة وتسكعه في كل شي. مع محمد شكري يطيب الحديث عن كل شي في هذا الوجود. وهكذا تبادلنا الأنخاب بعد أن وقع لي كتابه الخبز الحافي الطبعة التي طبعها على نفقته كما قال.
لقد عرفت أشياء كثيرة عن مدينة طنجة وعن روادها وزوارها من الأدباء والموسيقيين والكتاب، سواءً كانوا عرباً أو غربيين، وتجاربهم، خلال زياراتي المتعددة، وإقامتهم في هذه المدينة، وذلك من خلالي لقاءاتي وسؤالي محمد شكري عن تلك العلاقات وعمقها ومدى ارتباطه بهم. وكنت أسهم أحياناً بتذكيره بأمور تحدّثَ عنها من خلال مقابلاته الصحفية، أو ماذكره الآخرين عنه. وكذلك كنت أذكره بوقائع شارك فيها مع أصدقاء مشتركين بعلاقات صداقة ومودة مع شكري. وكان بودي لو كانت لديّ كاميرا تلفزيونية توثق ما يقوله وما يفعله، وكذلك المواقف التي عاشها معهم وكيف يجسدها لي في حكاية عن هؤلاء البشر. إنه سردي بارع في تسلسله للوقائع، وبارع في حبك حكاياته، وأعتقد غير مخطيء بأن محمد شكري يتفوق بسرده أحيانا عن كتب كتبها، وهذه ملاحظاتي الدقيقة والشخصية عنه. لكنّ أهم الأمور التي شعرتها وأحسست بها من خلال تجربتي معه حديثه عن عشقه للمكان ما كنت أعرفها في السابق بعمق، إلا من خلال ما يتجسد في عمل إبداعي سواءً كتابة قرأتـُهُا، أو موسيقى سمعتـُها، أورسم حضرت عرضه في جاليري، أوتمثيل شاهدته على مسرح دون معايشتها لواقعها التي جعلت حالتها تتميز عن حالات الإعتيادي والنمطي في حياتنا، رغم أن هذه الأمور الميتافيزيقية تـَكُونُ لغات الخطاب بها المشاعر والوجدان وخوضها كواقع وتجربة ثرية لا مفر منه مع إثباتات واقعية وحقيقية يشعر بها ويقرؤها ويصدقها من تتعايش معه. لقد عشق طنجة محمد شكري، وجسد ذلك العشق في مشروعه الكتابي ونمطية حياته بها برغم أنه كان يلاقي فيها مـُضَيـِّـقاتٍ من الناس الذين يعرفونه والذين لا يعرفونه في السنوات الأخيرة من حياته.
في نهاية منتصف الليلة الطويلة تلك قضيناها متنقلين نتسكع في ليل طنجة من حانة إلى حانة، ومن مطرح إلى آخر، وهويلح ويذكر لنا محاسن ومساويء تلك الأمكنة وعلب الليل ومن يرتادها من الأدباء، وغيرهم من المشهورين الذين يزورون المدينة، وكذلك الذين اتخذوها وطناً حتى أوصَـلـَـنا إلى مكان إقامته، وهو يدعونا في شقته على شراب من الـ"بيرنو" الفاخر حصل عليه هدية من ناشر فرنسي يزور المدينة، قال لنا بأنه سوف يصطحبنا غداً في الصباح إلى مدينة العرائش لزيارة قبر صديق لم يحدده لنا وربما نعرج على أصيلة والتى لم تكن مشهورة في تلك الفترة، لكن لا بد لمحمد شكري من مقابلة صديق يود أن يعرفنا به وهو صاحب فرقة الجناوة الموسيقية والذي كان يعيش في أصيلة، وذلك ما تم. لقد كان محمد شكري من اللحظة الأولى كريماً وودوداً حينما عرفته تلك الليلة، وهذا ما أخبرتني بها مشاعر مرافقتي، واتفقتْ معي آنا برسلس، خاصة وأنه يستميت في جدله وإصراره كي يدفع الفواتير عنا في بعض العلب الليلية. لقد كان مشهداً مدهشاً فاجاءنا به محمد شكري متصابياً، ونحن نودعه في الصباح الباكر بشقته، رافضاً الرضوخ لطلبنا بعدم النزول إلى الطابق الأرضي بحجة أنه ربما مغلق بالقفل تلك اللحظات، حيث عادة ما يقوم بها حارس العمارة. لقد كان قوياً مُعافىً يتقافز أمامنا أربعة أدوارعلى سلالم العمارة بحركات عبثية وبهلوانية يخفق لها فؤاد "آنا" الثملان.
وعندما رحلت عن طنجة ذلك الصيف كنت أحمل منها ذكريات جميلة وانطباعاً خاصاً بزيارتها مرة أخرى، متى ما أتاحت لي ظروف الحياة ذلك. ولكنني في واقع الأمر لم أتوصل لهدفي الذي من أجله جئت
لقد غيبت بنا الأقدار كل على حال سبيله، من أحداث ومن محن وأفراح وأسفار عاشها ومارسها أثناء عدم لقيانا. وكنت حينما أزور المغرب في المرات الأخرى يكون محمد شكري في خارج مدينته. فلم ألتقِ به في كثير من زياراتي لطنجة. لقد كان قدر الضبط القدري أن لا تتم تلك اللقاءات. وهذا شيء صحي، أحياناً لا بد منه، وعلى المرء أن يقتنع به . كنت ألتقي في المدينة بناس متعددة المواهب في مجال الموسيقى والغناء. وبصدفة متأخرة في زيارة من زياراتي التقيت بالروائي الأمريكي "بول باولز" صديقه القديم، والذي أصبح غريمه. حيث يقطن حينها في الدور الرابع بشقته في عمارة" إتيسا" بالحي الحديث دون هاتف أوجهاز تلفزيون.
في مساء صيف عام1989 التقيت محمد شكري وكانت تلك المرة في مقهى وحانة نزل الجنينة المجاور لنزل ماركوبولو بمدينة طنجة وبمعية من الأصدقاء والأدباء العرب الذي يزورون المغرب ذلك العام، حيث موسم أصيلة الثقافي في أوجه. ، غير أنه لم يكن في مزاجه وروقانه كما عهدته دوماً، بشوشاً وهزلياً إلى أبعد الحدود وما فوق السماوات. كان يتحدث إلينا كأنه نادم على أشياء كتبها لأن الناس لا تفهم ولا تفرق ما هو الأدب وقلة الأدب. وكان في حكاياته مرارة حبكة التجارب التي عاشها مع الكتاب والأدباء العرب ومرارة تلك التجارب من خلال لقاءاته بتلك العينات من الكتاب وما كتب عنه وعن تجربته عبر الملاحق الثقافية. بعد ليلة من تلك الجلسة اصطحبني في جولة مسائية سماها هو" طنجة أمكنتها ووجوهها في ذاكرتي". ومن مكان في عمق بطن السوق الداخلي قال لي من هنا بدأت أحس بخطواتي في هذه الحياة. إنه مشرب "الرقاصة". الحانة الفقيرة الحقيرة! كما يصفها، وهي البوابة الواسعة التي أدخلتني عالم طنجة. وكنت مندهشا برفقته وثرثرته الثملة عن الأمكنة في مدينته. وأثناء سيرنا في مصارين وأزقة تلك السوق كان يستوقفنا عن الحديث والسير مصافحة وعناق البشر وترديداتهم تحيات محبة وسلامتهم، بل وأنه كم من المرات كان يمد يده ويستخرج نقودا يوزعها هنا وهناك على عينات من الفقراء تتراوح أعمارهم من الرابعة عشر وحتى التسعين، يتسكعون بتلك السوق. كان السي محمد كما أسمعهم ينادونه في السوق يشق مصارين ومنعرجات السوق الداخلي بسرعة وكأنه حصان من حماس، وكان سيلاً أو شلالاً من الكلام والشتائم عند كل زاوية ومنعطف مررنا بها. وكان حديثه عن طنجة في كل شيء، في الخمسينيات والستينيات، يشد انتباهي، ويخرجني لحالة الواقع وما آل عليه حال الزمن وكيف وصلت عليه الحالة في المدينة. وحينما وصل بنا السير إلى منعطف يربط حي القصبة بوسط المدينة سألني عن نوع من أنواع المحار إن كنت تذوقته وتشتهر به المدينة يقدم مع "الروج" على الزاوية التي سنتوجه إليها، لكنه غيّر رأيه حينما قال لي إنها صاخبة هذه الحانة ومليئة بالحثالات والعاهرات والسكارى، ثم أردف وهو يلوح بيده، دعنا نذهب لمكان آخر، قالها بعصبية ثم أكملنا المسير وهو يتمتم، سنرى. لقد أخبرني حينما أجبرنا المطر الشديد بعد أن انزوينا بشرفة غرفتي في نزل "ماركوبولو" بأنه حينما كان في السابعة عشر من عمره تلقى طعنة من مدية في خاصرته اليمنى في تلك الزاوية التي يبتاع فيها ذلك النوع من المحار، كان ليلتها عندما أخبرني بتلك الحادثة يرشد بحارة من الفلبين في جولة مسائية للمدينة، لكنه قال لي وهو يرتشف كأساً من "شيفاز ريكال" ها أنت تراني أمامك لم أقبر بعد. كان الجرح سطحياً حتى أنه لم يستدعِ ذهابي للمستشفى، بل وأكملت مهمتي مع أولئك البحارة حتى الفجر. ثم قام بإزاحة ملابسه، حيث يكاد يُرَى شيءٌ من أثر ذلك. هكذا أكدته لنا من كانت ترافقنا، التي لصقت بنا في علبة ليل قبل ولوجنا للنزل. وخير ما فعلته بنت أحد شخصيات كتابه الأخير وجوه " فاطي" الرقطاء - كما يسمي أمها هو، وأسميها أنا هذه " الفتاة الزغبية"- في صبيحة يوم كنت أودعها على رصيف محطة القطارات في مدينة طنجة.











.jpg)













































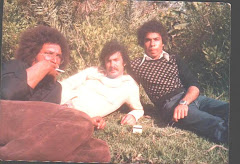













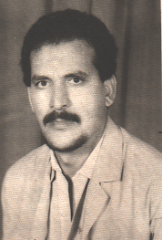









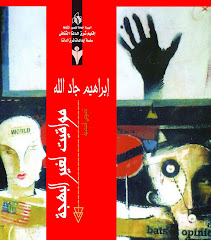

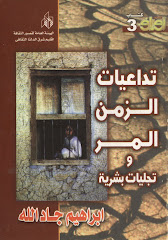









.png)









-001.jpg)











ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق