
علمنة المجتمع العربى ، والعلمانية
***
العلمانية تحاصر التطرف الدينى
فعلى العلمانيين مراجعة خطابهم
السجال بين العلمانيين ورجال الدين سجال مرشح للتهافت، وذلك لسببين، على الأقل: الاول أنه، في مجمله، غير قادر على تحديد موضوعه، والثاني أن الممارسة الاجتماعية هي المتعهّدة بحسمه. وهو حسم يزداد اتساعا وإيقاعا، برغم كل ما يسيل في المسامع وعلى الورق من هذا السجال. هذا يعني ان الوقت قد حان لتحويل النظر الى الواقع: واقع يتعلّمن، دون اكتراث لا بماضي السجال ولا بمصيره.
من الصعب ومن غير المفيد لملمة السجال الممتد من جهة المسائل المدرجة فيه. قد تكفي منه بعض تضاريسه: تاريخية العلمانية، والعلاقة بين علمانية الدين ودين العلمانية، وربط العلمانية بالمشروع الديموقراطي. وإذا كنا نذكرها، دون التوقف عند تفرّعاتها وتفصيلاتها، فلتأكيد استعصاء معادلاتها في الفكر العربي الذي تتجه الأنساق فيه، دوماً، الى التداخل، وبالتالي الى النسبية، خوفاً من (القطيعة).
التاريخية تعني، اولاً، رفض فرضية التجانس التي تقوم عليها رؤية الأمة. إنها تعني، تبعاً لذلك، أن العلمانية، من وجهة اجتماعية، هي علمانيات أنتجتها صيرورات اجتماعية طويلة المدى. ليست هي مجرد خطاب ولا هي ظاهرة ثقافية محض. هي وعي وتجربة. وبما ان العلمانية، من هذه الوجهة، لا تنفصل عن وجهها الثاني الذي هو الدين فإن ما يستفز فيها رجال الدين وهذا منتظر أن تاريخيتها هي وجه آخر لتاريخية الدين ذاته. هناك، اذاً، تقابل بين رؤية تاريخية للدين ورؤية دينية للتاريخ.
ظاهرياً، يبدو الطرفان، في المطلق، على طرفي نقيض. لكن بما ان العلماني هو (الدخيل) على الثقافة العربية ورجل الدين هو المستقر فيها فإن الاول لا تكفيه معرفته ولا ايديولوجيته وإنما عليه، فوق ذلك، إثبات هويته وبراءته. من هويته الدين، طبعا، فلا سبيل الى تجاوز حدوده المرسومة. هذا ضغط أول يجعل النص العلماني نصاً غير مكتمل، بالضرورة. أما البراءة فأولها على وجه التعميم والترهيب، البراءة من التواطؤ مع الفكر الغربي. من هنا كان البحث عن اصول للعلمانية في التاريخ العربي، سواء كان ذلك بعمق وذكاء مثلما فعل عزيز العظمة (من منظور مختلف) او كان على سبيل الاشارة والإرضاء، كما فعل الكثيرون. إنها حالات نادرة تلك التي لا ينبني فيها الخطاب العلماني العربي على هاجس طمأنة ما يعتبره طرفاً نقيضاً له. وهي طمأنة يحتاج إليها التاريخ ايضاً!
(برديغم) العلمانية له حدوده وتخومه في الفكر الغربي كنسق من المفاهيم والمقولات والقيم المترابطة. العلماني العربي، الباحث على الاقل، يعرف ذلك، ولكن الحديث عن العلاقة بين العلمانية والدين سرعان ما يوسع التداخل بينهما في الفكر العربي. هنا يصبح إثبات الهوية والبراءة اكثر حرجاً. لم تعد تكفي الطمأنة التي تفرضها مناورة التاريخ. لهذا كثيراً ما يتحول التبرؤ من معاداة الدين الى دفاع عنه، بصورة او بأخرى. ان القول يتكرر بأن الشعار اللاديني ليس شعاراً ضد الدين. وهو، في ذلك، يستنجد بعلاقة الكنيسة بالدولة والمجتمع في تاريخ أوروبا، متنقلا بين (لائكيّة) فرنسا (المحرجة، احيانا) و(سيكيلريزم) انكلترا التي تبدو له اكثر مرونة.
المقاربة السياسية للدين تعقد الموضوع اكثر. انها تقوم على مقولة سائدة لا تزال تتخذ شكل البديهية، وهي أنه لا فصل في الاسلام بين الدين والسياسة، ولا فصل فيه، تحديدا بين الدين والدولة. هذه المقولة التي استوعبتها أغلب الانظمة العربية، بل وحكمت بها شعارا، لا يجد العلمانيون لها حلا غير التراجع نحو مقولة أخف وطأة من فصل الدين عن الدولة هي الفصل بين حيز العام وحيز الخاص. إنه تراجع يسمح بالدفاع عن الدين كعقيدة للفرد الحق، كل الحق، في اعتناقها وفي ممارسة شعائرها (وهي، بهذا المعنى، من حقوق الانسان)، شريطة ألا تتحول، خارج هذه الحرية الفردية، الى مرجعية وحيدة والى مصدر شرعية لسلطة تمارس، باسم الدين، في الحيز العام الذي يجب ان يبقى فضاءً للحق في الاختلاف.
هذا التراجع لا يكفي، على ما يبدو. ذلك ان الانسحاب من الحيز العام يعني، في مجتمع عربي ما قبل مدني، تركه للدولة وحدها. ان الخوف الذي لا يعرف العلمانيون كيف يتدبرون أمره هو خوف رجال الدين من ان يكون الانسحاب لمصلحة الدولة، بينما الغلبة، كما تبدو آفاقها للبعض منهم، قد تكون لمصلحة الدين. ولهذا الأمل، عندهم، مؤشرات منها اثنان، في الأمد المنظور: أحدهما تنامي (إرهاب العدو) المحلي والعالمي، برغم محاربة (الارهاب) الذي ارتبطت تجلياته، في السياسة، بالدين، وثانيهما استمرار مقاومتهم في آخر معاقلها: المرأة. والواضح ان آخر معارك العلمانية هي علمنة حياة المرأة العربية، وخاصة جسدها الذي بدأ، فعلاً، يتعلمن
كل السجال يصب الآن في المشروع الديموقراطي. ليس هنا مجال الحديث عن صعوبات الديموقراطية او عن استحالتها في السياق العربي، خارج حدود (الاصلاح) الذي تفقد فيه أهم مبادئها. لنفترض جدلاً، ان الديموقراطية ممكنة. في هذه الحالة لا تكون إلا علمانية. نعرف البدائل، من وجهة دينية سياسية، ولكنها بدائل لها ان تحمل ما شاءت من اسماء، ما عدا الديموقراطية. الديموقراطية، في حدها الادنى، كتعبير عن حق الاختلاف، تصطدم بأية مرجعية تجانسية مفترضة او مفروضة، بما في ذلك دينيا. وكما كرر العلمانيون، يمكن للديموقراطيين ان يكرروا أنه ليس من همهم ولا من نواياهم مهاجمة الدين الذي ينتمون إليه ولا المتدينين الذين يحترمون عقائدهم وإراداتهم. المطلوب منهم، هنا، كما هي الحال في كل مناسبة، ان يكرروا ان التوجه العلماني هو في اتجاه الدفاع عن الديموقراطية لا في اتجاه مناهضة الدين. قد يلتجئون الى القول بأن الديموقراطي، كفرد، هو علماني متدين كما ان الدين، كممارسة، متعلمن.
يواجه الديموقراطيون العلمانيون تذكيرا مرا بأن العلمانية في العالم العربي ارتبطت تجاربها بالتسلط والاستبداد ولم تعرف اية تجربة ديموقراطية، خلافا لعلمانية الغرب التي وإن تحملت النازية والفاشية والستالينية، دعمت الديموقراطية وحصّنت استمراريتها. والمفارقة انهم لا يكادون يجدون من استثناء إلا في مجتمع طائفي كلبنان: وهو استثناء لن يصبح نموذجا للعرب إلا إذا استطاعت ديموقراطيته أن تلغي طائفيته السياسية وأن تحوّل عضو الطائفة الى مواطن. وهذا لا نراه يكون بدون علمانية لا تبقى معها المواطنة رهينة اختطاف طائفي. بدون ذلك يبقى الاستثناء اللبناني (حالة خاصة) مغرية، من بعيد، ولكن لا يمكن ان يعيشها، كحالة، إلا اللبنانيون، في لبنان.
حالات (التطرف الديني) تحتاج الى توضيح، في علاقتها بالعلمانية: هناك حالات، منها حالة الجزائر مثلا، توحي بأن علمانية المجتمع، واقعا او ممكنا، هي المستهدفة. هناك (تكفير) يؤدي الى بقر بطون الامهات والى قتل جنين محتمل (الكفر). هذا المشهد البشع هو، ايضا، مشهد اغتيال لعلمانية ما قبل (الكفر)، في مرحلة ما قبل المهد... لكن أوسع الحالات التي يتبنى فيها العنف المادي مرجعيات او شعارات دينية ليس من اهدافها الاولى، المعلنة على الاقل، محاربة العلمانية العربية وإنما هي، كما تعرّف نفسها، حالات (جهادية) يستنهضها الدين او تستنهضه ضد أعدائه الذين هم اوسع عدداً وفضاءً من فئة العلمانيين العرب. هناك ايضاً حالات مقاومة تحريرية لها قواعدها الشعبية، وقد تجد لها من يناصرها من العلمانيين انفسهم، رغم ما قد يكون لها من عناوين دينية. وهكذا فإن التقابل دين/ علمانية هو، في واقع العالم العربي الراهن، أقل حدية وأكثر تلويناً مما تريد له بعض النصوص، سواء كانت ذات نزعة علمانية او دينية. من هذه الوجهة، نفهم اكثر لماذا تحرص اغلب الكتابات على ترك مناطق للتداخل والنسبية، ولو كان ذلك على حساب قناعاتها الايديولوجية.
لا شك في ان للخطاب الديني، بصيغه المختلفة، أثراً لا يزال واسعاً في الاوساط الشعبية العربية. القول بخلاف ذلك تغطية للواقع الموضوعي وللأسباب التي وراءه والتي قد لا تكون لأغلبها أصول دينية. الخطاب العلماني ليس له هذا التجذر الاجتماعي. هذا، ايضاً، معطى موضوعي. في مرحلة إصلاحية تحديثية سابقة كان هذا الخطاب مؤثراً في اوساط النخب الفكرية والسياسية. هذه المرحلة النخبوية انتهت، لا لأن فكرها العلماني لم يعد مناسباً (فهو مناسب أكثر من أي وقت مضى) وإنما لأن المجتمع بدأ يتعلمن (من تحت)، بدون أخذ رأي النخبة، وبدون أن يكترث بعلاقة تعلمنه هذا بعلمانية العلمانيين.
لننظر الى ما يجري من علمنة حياتنا اليومية، وإن كان بدرجات متفاوتة وبصيغ ظاهرة او مستترة، حسب البلدان العربية: هناك، طبعاً، المؤسسات والقوانين المدنية والاحوال الشخصية وما الى ذلك مما أكسب العلاقات والسلوك سيولة تنحل معها بعض الصيغ الدينية في فضاءات الحيز العام. بعض الشوارع العربية لا تختلف تجلياتها عن شوارع العواصم الاوروبية: نساء لجغرافية الاجساد عليهن تضاريسها وحدودها التي تناست كل تعريف للعورة الفقهية. إعلانات ولغات تبيح للعين والسمع اصناف المكروه والحرام. هناك ايضا وكيف ننسى؟ ما يهب في الاعلام والاعلامية من مشاهد معولمة وقد تسيّبت من اطار الزمان والمكان. كل هذا وغيره يخترق كل الشرائح الاجتماعية، ولو بدرجات متفاوتة. لم يعد له حدود فئوية او طائفية. ذلك ان مقاومته وراء الخطاب تعني تعطيل كل الحواس تقريبا ليسلم الكائن الاجتماعي من مصادفته.
هذا الوضع هو بصدد تحويل الصدام بين التطرف الديني والدولة الى صدام بين التطرف الديني والمجتمع. هناك إشارات إلى تضايق المجتمع العربي من العنف الذي يمارس باسم الدين، وخاصة لدى الفئات الشعبية التي هي ضحيته الاولى. لقد بدأ العنف يظهر كأنه تشفٍّ من المجتمع نفسه: لأنه (يتسيّب)، اي يتعلمن، ولأنه يقبل الدولة المتهمة بعلمنته او بتركه يتعلمن.
التطرف الديني، بما فيه صيغ العنف، سينتهي بمواجهة المجتمع المتعلمن. قد يتطلب ذلك وقتاً لا نعرف مداه ولكن أغلب الاحتمال ان يدفع المتطرفين الى التنازل، تاركين للدين طريق العودة الى الحيز الخاص ولرجال الدين أوضاعهم وأدوارهم الدينية. بذلك تكون علمنة المجتمع قد حاصرت التطرف الديني كما تكون أوحت الى العلمانيين بإعادة بناء خطابهم في علاقته بالواقع الاجتماعي.
يواجه الديموقراطيون العلمانيون تذكيرا مرا بأن العلمانية في العالم العربي ارتبطت تجاربها بالتسلط والاستبداد ولم تعرف اية تجربة ديموقراطية، خلافا لعلمانية الغرب التي وإن تحملت النازية والفاشية والستالينية، دعمت الديموقراطية وحصّنت استمراريتها. والمفارقة انهم لا يكادون يجدون من استثناء إلا في مجتمع طائفي كلبنان: وهو استثناء لن يصبح نموذجا للعرب إلا إذا استطاعت ديموقراطيته أن تلغي طائفيته السياسية وأن تحوّل عضو الطائفة الى مواطن. وهذا لا نراه يكون بدون علمانية لا تبقى معها المواطنة رهينة اختطاف طائفي. بدون ذلك يبقى الاستثناء اللبناني (حالة خاصة) مغرية، من بعيد، ولكن لا يمكن ان يعيشها، كحالة، إلا اللبنانيون، في لبنان.
حالات (التطرف الديني) تحتاج الى توضيح، في علاقتها بالعلمانية: هناك حالات، منها حالة الجزائر مثلا، توحي بأن علمانية المجتمع، واقعا او ممكنا، هي المستهدفة. هناك (تكفير) يؤدي الى بقر بطون الامهات والى قتل جنين محتمل (الكفر). هذا المشهد البشع هو، ايضا، مشهد اغتيال لعلمانية ما قبل (الكفر)، في مرحلة ما قبل المهد... لكن أوسع الحالات التي يتبنى فيها العنف المادي مرجعيات او شعارات دينية ليس من اهدافها الاولى، المعلنة على الاقل، محاربة العلمانية العربية وإنما هي، كما تعرّف نفسها، حالات (جهادية) يستنهضها الدين او تستنهضه ضد أعدائه الذين هم اوسع عدداً وفضاءً من فئة العلمانيين العرب. هناك ايضاً حالات مقاومة تحريرية لها قواعدها الشعبية، وقد تجد لها من يناصرها من العلمانيين انفسهم، رغم ما قد يكون لها من عناوين دينية. وهكذا فإن التقابل دين/ علمانية هو، في واقع العالم العربي الراهن، أقل حدية وأكثر تلويناً مما تريد له بعض النصوص، سواء كانت ذات نزعة علمانية او دينية. من هذه الوجهة، نفهم اكثر لماذا تحرص اغلب الكتابات على ترك مناطق للتداخل والنسبية، ولو كان ذلك على حساب قناعاتها الايديولوجية.
لا شك في ان للخطاب الديني، بصيغه المختلفة، أثراً لا يزال واسعاً في الاوساط الشعبية العربية. القول بخلاف ذلك تغطية للواقع الموضوعي وللأسباب التي وراءه والتي قد لا تكون لأغلبها أصول دينية. الخطاب العلماني ليس له هذا التجذر الاجتماعي. هذا، ايضاً، معطى موضوعي. في مرحلة إصلاحية تحديثية سابقة كان هذا الخطاب مؤثراً في اوساط النخب الفكرية والسياسية. هذه المرحلة النخبوية انتهت، لا لأن فكرها العلماني لم يعد مناسباً (فهو مناسب أكثر من أي وقت مضى) وإنما لأن المجتمع بدأ يتعلمن (من تحت)، بدون أخذ رأي النخبة، وبدون أن يكترث بعلاقة تعلمنه هذا بعلمانية العلمانيين.
لننظر الى ما يجري من علمنة حياتنا اليومية، وإن كان بدرجات متفاوتة وبصيغ ظاهرة او مستترة، حسب البلدان العربية: هناك، طبعاً، المؤسسات والقوانين المدنية والاحوال الشخصية وما الى ذلك مما أكسب العلاقات والسلوك سيولة تنحل معها بعض الصيغ الدينية في فضاءات الحيز العام. بعض الشوارع العربية لا تختلف تجلياتها عن شوارع العواصم الاوروبية: نساء لجغرافية الاجساد عليهن تضاريسها وحدودها التي تناست كل تعريف للعورة الفقهية. إعلانات ولغات تبيح للعين والسمع اصناف المكروه والحرام. هناك ايضا وكيف ننسى؟ ما يهب في الاعلام والاعلامية من مشاهد معولمة وقد تسيّبت من اطار الزمان والمكان. كل هذا وغيره يخترق كل الشرائح الاجتماعية، ولو بدرجات متفاوتة. لم يعد له حدود فئوية او طائفية. ذلك ان مقاومته وراء الخطاب تعني تعطيل كل الحواس تقريبا ليسلم الكائن الاجتماعي من مصادفته.
هذا الوضع هو بصدد تحويل الصدام بين التطرف الديني والدولة الى صدام بين التطرف الديني والمجتمع. هناك إشارات إلى تضايق المجتمع العربي من العنف الذي يمارس باسم الدين، وخاصة لدى الفئات الشعبية التي هي ضحيته الاولى. لقد بدأ العنف يظهر كأنه تشفٍّ من المجتمع نفسه: لأنه (يتسيّب)، اي يتعلمن، ولأنه يقبل الدولة المتهمة بعلمنته او بتركه يتعلمن.
التطرف الديني، بما فيه صيغ العنف، سينتهي بمواجهة المجتمع المتعلمن. قد يتطلب ذلك وقتاً لا نعرف مداه ولكن أغلب الاحتمال ان يدفع المتطرفين الى التنازل، تاركين للدين طريق العودة الى الحيز الخاص ولرجال الدين أوضاعهم وأدوارهم الدينية. بذلك تكون علمنة المجتمع قد حاصرت التطرف الديني كما تكون أوحت الى العلمانيين بإعادة بناء خطابهم في علاقته بالواقع الاجتماعي.











.jpg)













































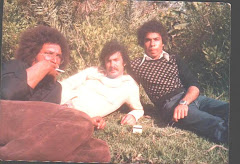













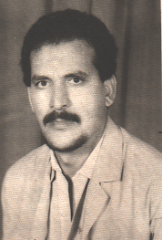









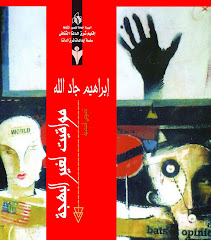

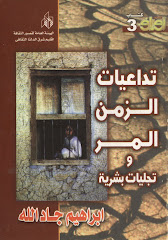









.png)









-001.jpg)











ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق