
مصارع الثيران بدون ال..موليتا
هى علاقة المثقف العربى بالسلطة
ابراهيم جادالله
في بحث له بعنوان <<ارث النهضة وأزمة الراهن>>، يتساءل المفكر المغربي عبد الله العروي في إطار بحثه عن أزمة الراهن: هل عرف أي قطر عربي في أي فترة من تاريخه حالة تسبق المجتمع على الدولة؟ لنقل معه حالة توظف فيها قدرات الدولة لتأسيس المجتمع على شكل يؤهله للاستغناء لاحقا وبالتدريج عن كثير من صلاحيات الدولة؟ (انظر مقدمات ليبرالية، المركز الثقافي العربي ،2000). بالطبع الجواب عن تساؤل العروي هو لا، فالمجتمع العربي منذ فترة بعيدة، حتى قبل أخطبوط الدولة التسلطية التي أكلت الأخضر واليابس وأزهقت أرواح البلاد والعباد والتي يستفيض خلدون النقيب في رسم صورتها البشعة والكريهة، لم يعرف تلك الحالة، وكل ما يملكه، لنقل، كل رصيده في العقود المنصرمة من القرن العشرين، هو حالة من الحراك الثقافي والاجتماعي الذي بلغ ذروته في الحرب الأهلية العربية التي انتهت بانتصار السلطة/الغول على المجتمع وتجييره لحسابها، بحيث أصبح المجتمع العربي شاهد زور لصالح الدولة التسلطية وتمسرحها المشوه على خشبات الحداثة والديموقراطية، حيث أدخل الاثنان من الخرم الضيق لدولة شرق المتوسط حيث كان على الحداثة أن تحل كحليف لها. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية من قرننا المنصرم، كان جل ما تطمح إليه النخب المثقفة الجديدة كما يسميها هشام شرابي والتي بنيت عليها آمال عراض في تحديث المجتمع العربي بكيفية شاملة ومسترسلة كما كتب العروي ذات مرة، هو عقدا اجتماعيا بصيغة مجازية، على أمل أن يكون شريعة للمتعاقدين. وجاءت أولى البواكير مع بداية عقد الثمانينيات من قرننا المنصرم، عندما دعا سعد الدين إبراهيم الذي قضى عقوبة في السجن مدتها سبع سنوات، الى تجسير الفجوة بين المثقف والأمير. كانت الدعوة الى تجسير الفجوة اقل بكثير من مستوى العقد الاجتماعي الذي تطمح إليه الأمة. ولكنها كانت دعوة الى المصالحة بين المفكر وصناع القرار. دعوة تجد طريقها إما على جسر ذهبي يلتقي عليه المثقف والأمير أو فضي أو خشبي، وعلى الأغلب خشبي يزحف عليه المثقف وهو مطأطئ الرأس باتجاه الأمير داعيا له بالسلامة وطول البقاء. وطوبى للسائرين على جسر خشبي. لم ترق الفكرة للدكتور غسان سلامة الذي كان عليه أن يخلف سعد الدين إبراهيم كأمين عام جديد لمنتدى الفكر العربي في عمان، حيث ظهرت صورته في مجلة المنتدى الى جانب الأمير الحسن بن طلال، ولكن ظروفا معينة حالت دون ذلك. لم ترق له الفكرة فراح يبحث عن عقد اجتماعي جديد طرفاه السلطة من جهة والمجتمع الأهلي من جهة ثانية (غسان سلامة، نحو عقد عربي اجتماعي جديد، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت). كانت الدعوة الى تجسير الفجوة بين المثقف والأمير، أو إلى عقد اجتماعي يمهد الى المصالحة، قد تزامنت مع التحول على صعيد الخطاب العربي المعاصر، وأقصد التحول من الثورة الى النهضة، وقاد لاحقا الى تراجع المثقف العربي الثوري الذي تشكل بتأثير خارجي والذي بنى عليه العروي آمالا كبيرة في عقلنة الماضي والحاضر بكيفية شاملة ومسترسلة. فكثر الحديث عن أزمة المثقف وأوهام النخبة ونهاية الداعية وتراجع دور المثقف/النبي... الخ. وفي سياق هذا التحول قام بعض المفكرون العرب بإعادة اعتبار للمثقف المبدئي الذي يقول كلمة الحق في وجه السلطة كما يرى ادوارد سعيد في <<صور المثقف>> والذي يتمتع بصورة شخصية مستقلة، محبة للاستكشاف والتحري، وذات نزعة نقدية اجتماعية تشتغل باسم حقوق الروح كما يقول محمد أركون، والتي ينتظر منها المجتمع العربي مهام محسوسة لان الحال العربية لا تحتمل التأجيل، وهذا ما يدعو إليه حليم بركات في كتابه <<المجتمع العربي في القرن العشرين،2001). كانت إعادة الاعتبار للمثقف تصدر عن رؤية ودور للمثقف الفدائي كما يسميه قسطنطين زريق أو المثقف المبدع كما يسميه حليم بركات. لنقل عن دور كبير للمثقف في المشروع النهضوي الجديد الذي راح يبشر به ناصيف نصار وحسن حنفي وهشام شرابي والذي هو بالضرورة مشروع سياسي يرمي الى إصلاح الدولة وتحديث المجتمع العربي وتحرير المرأة ويلقي بكاهله على عاتق المثقف. كان إصلاح الدولة يعني بالنسبة للمثقف الارتقاء بالدولة من دولة العصبية الى الدولة الحديثة، دولة جميع المواطنين. وهذا يعني أن تكون الدولة في خدمة أهداف المجتمع وليس العكس. وكان يعني هذا أن المثقف سوف يرتطم بصخرة السلطة وامتيازاتها التي لا تعد ولا تحصى. وهذا ما حصل بالفعل، فعلى طول المسافة التاريخية الممتدة من ستينيات القرن المنصرم الى بداية القرن الحالي، كانت <<أزمة المثقفين>> شاهدا باستمرار على أن السلطة العربية لا تقبل المشاركة في صنع القرار ولا في الحياة السياسية، وان الديموقراطية المرفوعة كشعار لا تزيد عن كونها لعبة بهدف خداع الجماهير، وان الوطن لا يزيد عن كونه ملكية عقارية للمؤسسة العسكرية والضباط الأحرار، كما يعلق أنور عبد الملك في كتابه <<مصر مجتمع جديد يبنيه العسكريون>> (1964). من هنا، يمكن القول انه من خريف القاهرة الذي شهد تجاذبا حادا بين السلطة والمثقفين وانتهى ب<<أزمة المثقفين>> التي لخصها محمد حسنين هيكل في كتابه <<أزمة المثقفين>>، (1961) <<بأنها تتمثل في عدم تبعية المثقف للثورة، بصورة أدق، في رفض المثقف لسلطة المؤسسة العسكرية>>، داعيا إياها للعودة الى الثكنة العسكرية وإفساح المجال للأمة في اتخاذ قراراتها المصيرية والديموقراطية، الى ربيع دمشق الذي مرّ مرَّ السحاب، لنقل كسحابة صيف. بقي المثقف كبش فداء، أو مصارع ثيران بدون <<موليتا>> بحسب تعبير محمد أصبور في كتابه <<المعرفة والسلطة في المجتمع العربي>> (1992)، حيث <<الموليتا>> هي قطعة القماش الحمراء التي يدرأ بها مصارع الثيران الموت عن نفسه. وفي كل الأحوال كان مشروع إصلاح الدولة وتحديث المجتمع العربي ينتهي الى أنفاق مسدودة تفضي الى الباحة الخلفية للسجن باعتباره العلامة الفارقة لدولة شرق المتوسط على حد تعبير الروائي عبد الرحمن منيف، التي قامت باختراق المجتمع العربي وتجييره لصالحها والحؤول دون كل عملية تغيير من شأنها أن تمس امتيازات السلطة العربية التي عاهدت نفسها على الثبات ضد كل عملية تغيير
في بحث له بعنوان <<ارث النهضة وأزمة الراهن>>، يتساءل المفكر المغربي عبد الله العروي في إطار بحثه عن أزمة الراهن: هل عرف أي قطر عربي في أي فترة من تاريخه حالة تسبق المجتمع على الدولة؟ لنقل معه حالة توظف فيها قدرات الدولة لتأسيس المجتمع على شكل يؤهله للاستغناء لاحقا وبالتدريج عن كثير من صلاحيات الدولة؟ (انظر مقدمات ليبرالية، المركز الثقافي العربي ،2000). بالطبع الجواب عن تساؤل العروي هو لا، فالمجتمع العربي منذ فترة بعيدة، حتى قبل أخطبوط الدولة التسلطية التي أكلت الأخضر واليابس وأزهقت أرواح البلاد والعباد والتي يستفيض خلدون النقيب في رسم صورتها البشعة والكريهة، لم يعرف تلك الحالة، وكل ما يملكه، لنقل، كل رصيده في العقود المنصرمة من القرن العشرين، هو حالة من الحراك الثقافي والاجتماعي الذي بلغ ذروته في الحرب الأهلية العربية التي انتهت بانتصار السلطة/الغول على المجتمع وتجييره لحسابها، بحيث أصبح المجتمع العربي شاهد زور لصالح الدولة التسلطية وتمسرحها المشوه على خشبات الحداثة والديموقراطية، حيث أدخل الاثنان من الخرم الضيق لدولة شرق المتوسط حيث كان على الحداثة أن تحل كحليف لها. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية من قرننا المنصرم، كان جل ما تطمح إليه النخب المثقفة الجديدة كما يسميها هشام شرابي والتي بنيت عليها آمال عراض في تحديث المجتمع العربي بكيفية شاملة ومسترسلة كما كتب العروي ذات مرة، هو عقدا اجتماعيا بصيغة مجازية، على أمل أن يكون شريعة للمتعاقدين. وجاءت أولى البواكير مع بداية عقد الثمانينيات من قرننا المنصرم، عندما دعا سعد الدين إبراهيم الذي قضى عقوبة في السجن مدتها سبع سنوات، الى تجسير الفجوة بين المثقف والأمير. كانت الدعوة الى تجسير الفجوة اقل بكثير من مستوى العقد الاجتماعي الذي تطمح إليه الأمة. ولكنها كانت دعوة الى المصالحة بين المفكر وصناع القرار. دعوة تجد طريقها إما على جسر ذهبي يلتقي عليه المثقف والأمير أو فضي أو خشبي، وعلى الأغلب خشبي يزحف عليه المثقف وهو مطأطئ الرأس باتجاه الأمير داعيا له بالسلامة وطول البقاء. وطوبى للسائرين على جسر خشبي. لم ترق الفكرة للدكتور غسان سلامة الذي كان عليه أن يخلف سعد الدين إبراهيم كأمين عام جديد لمنتدى الفكر العربي في عمان، حيث ظهرت صورته في مجلة المنتدى الى جانب الأمير الحسن بن طلال، ولكن ظروفا معينة حالت دون ذلك. لم ترق له الفكرة فراح يبحث عن عقد اجتماعي جديد طرفاه السلطة من جهة والمجتمع الأهلي من جهة ثانية (غسان سلامة، نحو عقد عربي اجتماعي جديد، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت). كانت الدعوة الى تجسير الفجوة بين المثقف والأمير، أو إلى عقد اجتماعي يمهد الى المصالحة، قد تزامنت مع التحول على صعيد الخطاب العربي المعاصر، وأقصد التحول من الثورة الى النهضة، وقاد لاحقا الى تراجع المثقف العربي الثوري الذي تشكل بتأثير خارجي والذي بنى عليه العروي آمالا كبيرة في عقلنة الماضي والحاضر بكيفية شاملة ومسترسلة. فكثر الحديث عن أزمة المثقف وأوهام النخبة ونهاية الداعية وتراجع دور المثقف/النبي... الخ. وفي سياق هذا التحول قام بعض المفكرون العرب بإعادة اعتبار للمثقف المبدئي الذي يقول كلمة الحق في وجه السلطة كما يرى ادوارد سعيد في <<صور المثقف>> والذي يتمتع بصورة شخصية مستقلة، محبة للاستكشاف والتحري، وذات نزعة نقدية اجتماعية تشتغل باسم حقوق الروح كما يقول محمد أركون، والتي ينتظر منها المجتمع العربي مهام محسوسة لان الحال العربية لا تحتمل التأجيل، وهذا ما يدعو إليه حليم بركات في كتابه <<المجتمع العربي في القرن العشرين،2001). كانت إعادة الاعتبار للمثقف تصدر عن رؤية ودور للمثقف الفدائي كما يسميه قسطنطين زريق أو المثقف المبدع كما يسميه حليم بركات. لنقل عن دور كبير للمثقف في المشروع النهضوي الجديد الذي راح يبشر به ناصيف نصار وحسن حنفي وهشام شرابي والذي هو بالضرورة مشروع سياسي يرمي الى إصلاح الدولة وتحديث المجتمع العربي وتحرير المرأة ويلقي بكاهله على عاتق المثقف. كان إصلاح الدولة يعني بالنسبة للمثقف الارتقاء بالدولة من دولة العصبية الى الدولة الحديثة، دولة جميع المواطنين. وهذا يعني أن تكون الدولة في خدمة أهداف المجتمع وليس العكس. وكان يعني هذا أن المثقف سوف يرتطم بصخرة السلطة وامتيازاتها التي لا تعد ولا تحصى. وهذا ما حصل بالفعل، فعلى طول المسافة التاريخية الممتدة من ستينيات القرن المنصرم الى بداية القرن الحالي، كانت <<أزمة المثقفين>> شاهدا باستمرار على أن السلطة العربية لا تقبل المشاركة في صنع القرار ولا في الحياة السياسية، وان الديموقراطية المرفوعة كشعار لا تزيد عن كونها لعبة بهدف خداع الجماهير، وان الوطن لا يزيد عن كونه ملكية عقارية للمؤسسة العسكرية والضباط الأحرار، كما يعلق أنور عبد الملك في كتابه <<مصر مجتمع جديد يبنيه العسكريون>> (1964). من هنا، يمكن القول انه من خريف القاهرة الذي شهد تجاذبا حادا بين السلطة والمثقفين وانتهى ب<<أزمة المثقفين>> التي لخصها محمد حسنين هيكل في كتابه <<أزمة المثقفين>>، (1961) <<بأنها تتمثل في عدم تبعية المثقف للثورة، بصورة أدق، في رفض المثقف لسلطة المؤسسة العسكرية>>، داعيا إياها للعودة الى الثكنة العسكرية وإفساح المجال للأمة في اتخاذ قراراتها المصيرية والديموقراطية، الى ربيع دمشق الذي مرّ مرَّ السحاب، لنقل كسحابة صيف. بقي المثقف كبش فداء، أو مصارع ثيران بدون <<موليتا>> بحسب تعبير محمد أصبور في كتابه <<المعرفة والسلطة في المجتمع العربي>> (1992)، حيث <<الموليتا>> هي قطعة القماش الحمراء التي يدرأ بها مصارع الثيران الموت عن نفسه. وفي كل الأحوال كان مشروع إصلاح الدولة وتحديث المجتمع العربي ينتهي الى أنفاق مسدودة تفضي الى الباحة الخلفية للسجن باعتباره العلامة الفارقة لدولة شرق المتوسط على حد تعبير الروائي عبد الرحمن منيف، التي قامت باختراق المجتمع العربي وتجييره لصالحها والحؤول دون كل عملية تغيير من شأنها أن تمس امتيازات السلطة العربية التي عاهدت نفسها على الثبات ضد كل عملية تغيير











.jpg)













































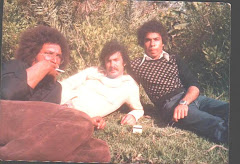













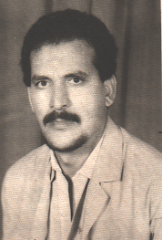









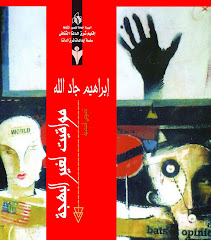

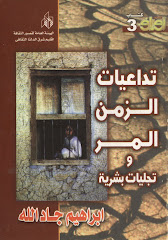









.png)









-001.jpg)











ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق