
القراءة عملية معقدة، والرواية خاصة إن لم تقرأ قراءة اختزالية على أنها ضرب من ضروب الأدلة والشهادات الاجتماعية السياسية تورط القارئ فيها، لا بسبب براعة الكاتب وحسب، بل وبسبب من الروايات الأخرى أيضا، فالروايات جميعا تنتمي إلى عائلة، وكل قارئ للروايات هو قارئ للعائلة المعقدة التي تنتمي إليها جميعا.
وفي الأدب العربي مجموعة غنية من الأشكال السردية، قصة قصيرة، سيرة، حديث، خرافة، أسطورة، خبر، نادرة، مقامة، ولم يصبح أي منها النمط السردى الرئيس كما فعلت الرواية الأوروبية ، غير أن الحقيقة تبقى متمثلة في أن هنالك رواية عربية حديثة خضعت خلال القرن العشرين لتحولات متعددة ولافتة، ولقد أنتجت اليوم تشكيلة واسعة جدا من المواهب والأساليب والنقاد والقراء المجهولين إلى أبعد الحدود، أو الذين يتم تجاهلهم عمدا خارج المنطقة العربية.
ومن المؤكد أن اللائمة في هذا الإخفاق المعرفي المؤسف يجب أن تلقى بقدر كبير على كون الهاجس الغربي الحاكم إزاء العرب ينحصر أو يكاد بكونهم مشكلة سياسية، غير أنه لم يعد اليوم ثمة مبرر لهذا الإخفاق، فقد بدأت ترجمات جاسيك المرهفة، كترجمة زقاق المدق لنجيب محفوظ، وأيام الغبار لحليم بركات، وترجمات دينس جونسون ديفيز تنال الرواج الذي تستحقه فعلا
بين النقد والإبداع
والعلاقة بين النقد والإبداع فى الثقافة العربية ذات طبيعة إشكالية ، وهى فى الحقيقة ملغومة بسوء النية والشك وعدم الاعتراف. فالكاتب صاحب الأثر الشعرى أو القصصى أو الروائى ، لا يقر بان الناقد له مشروعه الشخصى مثلما للمبدع مشروعه ، وهو من ثم يتعامل مع النقد بصفته نوعا من مراجعات الكتب ، وربما كمديح لما يكتبه ، لا كمشروع مواز لمشروعه هو.
من هنا نشأ الالتباس الذى أتى دائما على هيئة اتهام للناقد بأنه لا يتابع ، ولا يقرأ ويهمل الكتابات الجادة ، ويركز على الأسماء التى يظنها كبيرة وراسخة دون الالتفات إلى الأسماء الطالعة الجديدة ، والتى ربما يعلو شأنها الإبداعى أكثر من غيرها ، والتى يتهيأ لها ان ماتكتبه يتجاوز ما كتبته الأجيال السابقة ، وعلى حواشى هذه الرؤى تدور رحى الصراع بين الكتاب والنقاد ، حيث يُجرَّد النقاد من صفة الإبداع ويُختزلون إلى مجرد مراجعى كتب وموزعى مدائح أو شتائم ، لا فارق ، لكن تعريف النقد لا يقع فى خانة من هذه الخانات ، والناقد مثل الكاتب يحاول أن ينجز مشروعه الشخصى فى الكتابة النقدية ، وما يكتبه من مراجعات يدخل فى العادة ضمن قراءة الظواهر الإبداعية فى الشعر والقصة والرواية والمسرح والفن التشكيلى والموسيقى وخلافه.
وقد اعتاد النقد أن يبدأ بعد التصنيف ، أى بعد تحديد النوع الأدبى الذى يندرج فيه النص، لأن تحديد الهوية النوعية للنص يمكًَن الناقد من معالجته نقديا فى ضوء معايير وقواعد النوع الذى ينتمى إليه . إذ أن تحليل النصوص الأدبية لم يعد ممارسة فوضوية وانطباعية لا تهتدى بشروط تُنظّم العملية النقدية ، إنما على العكس ، فمنذ فترة طويلة اشتق النقد له جملة من المعايير يقترب فى ضوئها من النصوص ليفحص النظم الأسلوبية والبنائية والدلالية لها ، وذلك جزء من التنظيم الداخلى الذى يقتضيه كل نقد يطرح نفسه بوصفه حوارا مع النص ، واشتباكا معه ، ووسيلة لاستكشاف المستويات المضمرة فيه ، ودلالاته فى تضاعيفه
هل هى رواية مرآوية ؟؟
هل التصنيف النوعى للنصوص أمر يسير أم انه أصبح مهمة عسيرة ؟.
أضع هذا السؤال أمامى وأنا أحاول أن أقدم محطات نقدية نظرية لنص روائى جديد الهوية وواضحها أيضا للروائىأحمد صبرى أبو الفتوح ، التى أقدمها ليس انطلاقا من الرؤية القائلة بأن الأدب مرآة عاكسة – بشكل ما – للتجارب البشرية ، فهذا موضوع خلافى عالجته نظرية الأدب، وشغلت به منذ أرسطو إلى الآن ، إنما من وجهة نظرنا أن الرواية ليست مرآة المجتمع لأن المرآة تعكس الأشياء كما هى ولا تغيٍّر أى شيء فيها وتقوم بعملية تحويل لما يقع فى العالم من الواقع السياسى أو الاجتماعى أو أى شيء آخر، ويقوم الروائى هو الآخر بوضع رؤيته الفنية على هذه الأشياء والتى تشبه مزيج من الألوان ثم تخرج بنحو مختلف، وبالتالى هى ليست انعكاس مثل المرآة ، فضلاً عن أن الكاتب لو صور الأشياء كما هى فلن يصبح سوى شخص ينقل بعض المعلومات دون إعطاءها أى حس فنى ويجعلها تبدو معلومات وبيانات وليس صورة خًلقية فنية جميلة تميزها عن غيرها،وإن القول بالوظيفة ( المرآوية ) للنصوص الأدبية نًقِضَ منذ أكثر من قرن ، حينما اكتشف النقد عمق التباين بين العالمين ، العالم الواقعى المعيش ، والعالم الخطابى المتخيل ، مع أنهما يوحيان بالتماثل على درجة يبدوان فيها متماهيين ببعضهما لدى المتلقى العادى ، إلا أنهما شديدى الاختلاف فى ما بينهما من ناحية المكونات والعناصر .وهو ما تبرزه بجلاء ( جمهورية الأرضين ) فالعالم الخطابى لها محض تشكيل لغوى وإيديولوجى يتكون فى مخيلة المتلقى بالقراءة ولا وجود له قبلها ، بل إنه عالم ساكن الرواية ، تقوم القراءة بتنشيطه وبعث الحياة فيه ، فكيف يمكن اعتباره مناظرا للعالم الواقعى ؟ . هذه إحدى الإشكاليات الفنية التى تطرحها هذة الرواية ، والتى تحتاج لمجرى حديث آخر ، نوقن أهمية تحقيقه مستقبلا .
كيف لنا أن نتخطى أية مشكلات نظرية خاصة بهوية هذا النص الروائى من دون ان نلحق به ضررا يخفض من قيمته الإبداعية الكبيرة ؟ ، وقبل ذلك هل تحتاج القراءة النقدية إلى إثارة أسئلة قبل أن تصل إلى هدفها ؟
لاتقرأ رواية ( جمهورية الأرضين ) لأحمد صبرى أبو الفتوح بنهم ، هذا ما قلته لصديق روائى سعيت لكى يهديه صاحب الرواية روايته.
لا تقرأ بنهم ، لأنك كلماتقدمت فيها سطورا و صفحات ، أجبرتك رغبة بالعودة إلى الوراء، باحثا عن مكامن الكثافة والخفة ، وما يتكاثر متنوعا بينهما. إن أى ما تتناوله الرواية من مشاكل أو موضوعات ، سواء كثيفة الأهمية أو عاديتها . لا مانع منها، ولكن هناك شرط أساسى لكى نتجنب تأثر هذا الفن بمثل هذه المشاكل، وهو أن تكون الكتابة استوفت شروطها الفنية ، وهاهى (جمهورية الأرضين) مستوفية الشروط الفنية تماما ، من بنية درامية مسبوكة سبكا رصينا ، لم تخذلها اللغة التى توازت مع فوران الحدث الرئيسى للرواية،وجاءت اللغة كأساس البنيان الروائى وليست ناقلة أفكار أو حاملة معابد بل صارت جزءا من هذا النسيج القوى وقداهتم الروائى بها جيداً لأنها تعتبر العنصر الرئيسى والمؤثر فى الرواية، فاللغة فن تعبيرى ، له مفعول السحر خاصة وإذا كانت هذه اللغة مغلفة بشيء من اللون الأدبى والفني، فلم يو ظف أحمد صبرى اللغة أولاً لأنها كما ذكرت عنصر أساسى وقوى فى النص، ولم يشأأن يستخدمها كوسيلة للوصول إلى شيء آخر، وبالتالى هى ليست أداة تعبيرية فقط بقدر ما هى جزء من السياق النصى البحت، وهى شكل من أشكال وملامح شخصية الكاتب• ثانياً عندما أراد أن يعبر عن شيء فلم يوظف من أجله شيء آخر مثل اللغة ولكنه استخدم رموزا و تأثيرات واستلهامات مكانية و زمانية لكى يعبر عما يريده، وهنا أؤكد للمرة الثانية أن اللغة لم توظف ولم تستخدم كزخرف جمالى أو أداة تعبيرية فهى أكثر من ذلك ، وأن يكون صاحبها أبدع فى اقتراح أسلوبه وشخصيته المميزة عن غيره، أيضا ما قدمه أحمد صبرى من برولوج لم يجنح إلى تقريرية ، وإن كان قد حاور نفسه عشرات المرات عن ضرورة هذا البرولوج كشكل نصى يقارب السرد الروائى ، أو يحاذيه أو يناظره ولا يغنى عنه من الإمتاع شيئا ووقف فى المنطقة الوسطى بين صرامة المؤرخ وحيوية المبدع الذى نفح التاريخ نفسا حداثيا توهجت من نوره كافة التفاصيل الدقيقة فى الرواية ، وهو عمل سردى ليس منفصلا عن تاليه ، ولكنه أيضا قائم بذاته ولذاته ، وليس كما استوحى البعض معنى بالخذلان مؤداه أن الراوى افترض مسبقا جهلا لدى المتلقى بخلفيات تأخذ بيد القارىء المتعثر إلى مناخ النص ، وبالتالى فقدكتب نصاً فنياً جميلاً وراقياً وهذا بصرف النظر عما تضمنه النص من أمور تمت معالجتها فيه ، وأنا أعتقد أنه كلما دخل الروائى فى تفاصيل واقعه العام كلما كان ملبياً لحاجات القارئ حتى إذا كان الإلحاح والهاجس الرئيسى لهذا القارئ هو أمر سياسى فلا بأس ، وقدعالجه الروائى ، ولكن برؤية مغايرة وبعيدة تماما عن رؤية الإعلامى والصحافى وحتى المفكر السياسى• لأنه مسبقا قد تحلى بوعى فنى كاف وتمكن من أدواته الفنية والأدبية، ومن هذا المنطلق لم توجد أى حدود للكتابة عنده لأنها تحددت برؤيته المنفتحة فكانت كتابته الروائية منفتحة أيضا وهو ما نريده خاصة فى المرحلة القادمة وسط كل التحديات التى نقابلها، فضلاً عن أن الكاتب لا يستطيع أن يكتب حرفاً دون حرية كاملة له ولكتاباته. ولهذا كان هذا زمنها الحقيقى ، لا الزمن الإسقاطى .زمن فكرتها ، التيمة الرئيسة ، الشكل السردى ، فى حركته وتناميه ، وتصاعد الأحداث كما يراءى لها ا لروائى أن تكون فى الواقع.
إن روح التجوال التاريخى أو اللائذ بالتاريخ التي استولت عليه، بعد أن كانت قد استولت على روح جيل كامل في الستينيات والسبعينيات، ظلت تأخذه إلى رغبة السرد الروائي، ليس لأنه ولد روائيا، فلا أحد يتحدّد قبل أن يكتب ويتشكل في سياق، بل لأن كل الرواة يولدون عادة لأن حالة الشتات تستدعيهم، بل وتخلق لهم هذه الرغبة في السرد والقص لإنقاذ العالم من الزوال والعدم، أو ليعيشوا بالأحرى.
ويمكننا أن نجد بالفعل أن رغبته المحمومة في معرفة كل شيء وتجريب كل شيء تنداح فى محاولة الاستحواذ على أكبر قدر من الشخصيات والحياة التي لا تخصه وحده، بل وتخص الآخرين.
هم آخرون لغة، ولكنهم هنا لا علاقة لهم بآخرين كتب عنهم سارتر في مسرحية (الجحيم هو الآخرون)؛ إنهم رفاق الطريق والحانات والحياة المترددة بين كونها واقعا يشبه الخيال وخيالا يشبه الواقع.
احمد صبرى يكثف الملامح الواقعية ويكثر من التفاصيل لينهض نصه بشخصيات رواياته إلى مستوى الشخصيات الخيالية. ومن الصعب أن يقتنع قارئ روايته أن التصوير والرسم الأخيولي الذي يلجأ إليه في تخطيط وتلوين شخصيات(جمهورية الأرضين) هي شخصيات واقعية بالفعل. الأمر يعتمد على مهارة الكاتب، ، وعلى قدرته في أن يجعل القارئ يقرأ الشخصية الواقعية وكأنه يقرأ أخيولة. ولا عجب في هذا حين يصدر عن راوية يمضي أيامه ولياليه في مراقبة من حوله، وفي ملاحقة أحلامهم أيضا. ، وخلط ملامح الشخصية الإنسانية فى موجبها وسالبه ، متخطيا ، أو متجاوزا محطات الزمان ، تلك التى قد تغير من الإيقاع السلوكى / السيكولوجى،والأخلاقى والإجتماعى ، او حتى السيماء البيولوجى .
المأساةُ الماثلة فى التفسخ الأسرى ، والرغبة الدموية الحيوانية فى التلسط والقمع والتفسخ الإنسانى من أجل السلطة وبريقها ليست من المشاهد المحببة ولا المحبذة، ويجب أن تنكسر حدّتها، أي يجب أن نحوّلها إلى فن، ربما كي لا نتحجر في مواجهة (ميدوزا) الواقع. وهذا هو ما فعله الراوية بأكثر المشاهد والشخصيات مأساوية. فبعد أن التقطها، وهو قابع في زاويته، والتقط معها تاريخ القمع والاضطهاد والجنون والبراءة القتيلة، ( ورد الخال ونجم الدين والظربان وغيرهم ) نظر إليها مواربة في مرآة الكلمات لكي ينجو من نظرة الموت التي يسلطها هذا الواقع، تماما مثلما تخيل (ايتالو كالفينو) فعل الإبداع الفني.
إن العالم رديء، فقد فكرنا مع عدد كبير من أفراد جيلنا بتغيير العالم، ولكن هذه الفكرة الجميلة أصبحت بلا معنى لأن المافيات وعصابات الجريمة الخفية والمعلنة والطغاة وزبانيتهم أصبحت تحرك الأحداث وتؤثر في الواقع أكثر مما تحركه الأحزاب والمنظمات الثورية وحركات التغير المدنية ، محتجة أو رافضة . وأمام هذا لا نجد سبيلا إلا الدفاع عن النفس، إلا إعادة الصفاء إلى اللغة التي فقدت مصداقيتها وبسبب كثيرين ممن حوّلوها إلى بكائيات أو إلى لغة تهديد ووعيد.
هو إذن لم يفكر بتغيير العالم، بل بالرحيل في أعماق التاريخ المنسية والمجهولة حاملا روحا؛ روحا تحس بثقل هذا العالم ولكنها تجاهد لتجعله شفافا بالفن.
جاء بالأنا من خلال الآخرين المتباعدون فى التاريخ ، والآخرون من خلال الأنا القائمة فى الواقع؛ هذا هو مغزى هذا الحشد من الوجوه التي تجتمع فى الرواية ، في الحياة وفي الموت الذى يساوى الحياة أيضا لدى الطغاة ؛ ، وألوان متنوعة، ورغبات وأحلام متنافرة أو متناغمة، وأمكنة ذابت وظلت في المخيلة، وأمكنة يضغط حضورها على الراوي وعلى حواف صوره وسخرياته وزاوية نظره. مهما ابتعد الكاتب في تخطيه للثقيل والمأساوي، ووصل إلى عالم صاف وخاص، لن يستطيع الإفلات من مادة هذا العالم، سواء تمثلت في خيبة وفشل فكرة التغيير؛ ومقاومة أفكار فاشستية كتوريث الحكم ، الذى يعنى توريث البشر والأرض والحياة والمستقبل ، أو تمثلت في سطوة المافيات والبشاعة والديكتاتورية.
لهذا السبب ربما لا يستطيع احمد صبرى الإفلات من سطوة المكان، فهو يتردّد في روايته بين الخارج المتمثل بالمكان التاريخى الحامل مواريث من الديكتاتورية والقمع ، والداخل الشاهد على ملامحه الحديثة، أو بين منفى المكان التاريخى ،ومنفى المكان الداخل فى الواقع المعاش ،بين حاضره وذاكرته.
لايعيش الكاتب (هاجسه) الخاص، بل هواجس جمعية، فقد تقاطعت سيرة حياة الطاغية مع سير حياة الآخرين حوله، وتقاطع كل هذا مع أحداث وتواريخ. صحيح أن كل فرد يعيش زاويته الخاصة، ولكن من هذه الزاوية يمكنه أن يرفع نظره ويرى انفجار كوكب الحياة أو مرور مذنب التغيير مثلما ينظر الآخرون، وتنشأ هذه العلاقة الغامضة بين البشر. هذا العالم الذي ينعكس في رواية الروائى المتوحد احمد صبرى هو عالم مشترك، يتعارف فيه الناس حتى وإن لم يتعارفوا، فلا بد أن كل واحد من زاويته راقب النجم نفسه الذي هوى، أو استمع إلى الخبر نفسه الذي بثه التلفازعن حركة جموع رافضة قلقة على مصير وطن ، ولا بد أن كل واحد منهم حلم ذات يوم أنه أكبر من هذا الوجود الضيق الذي حشره فيه نظر حسير وبصيرة عمياء
الخصوصية الفنية والتأويل
هنا صار أحمد صبرى مهتما بنمط من الكتابة الروائية، هو التوق لإنتاج نص فيه من ثراء الخصوصية الفنية ما ينتمي إليه دون سواه، وهو هنا ليس متحمساً لفلسفة الخطاب الروائي التي من شأنها إغراق النص بالتأويل دون الخوض في تعرية المفردات التي تشكل بيئة الحدث، والتي تؤدي إلى إنتاج دعائم الرؤية الجديدة للنص، والمتمعن في تلك الرواية يجد أن الحدث يتسع ويتشابك ضمن وحدة درامية متكاملة، وإن بدا للوهلة الأولى كأنه نمو منقطع في دوائر سردية غير متصلة إلا ضمن الإطار العام للحدث، فالجملة السردية تحتمل الكثير من الانعطافات الزمانية والمكانية والاستغراق في تأسيس بيئات ناشطة ومؤثرة في تداعيات الحدث الكلي، هذه البيئات تتصل بالمسرح الأساسي بثيمات تخضع للكثير من التأويل والكشف، وتعكس الترابط المنطقي والسيميائي للأفكار إذا ما أراد لها أن تشارك في تفكيك جدلية معينة. ينطلق أحمد صبرى في تأثيث بيئة النص الروائي من إحداث اضطراب وصفي لحدث معين، أي يجعل من الحدث سبباً لتداعيات متتالية تتداخل لغوياً لإنتاج نسيج متسلسل يمتد ليشمل مساحة النص الروائي، ويكاد القارئ يشك بماهية الحدث الفعلي للرواية أو تشخيصه وفق رؤية تقليدية للتعامل مع هكذا نصوص، وهذا لا يعني أن القارئ يعاني من فقر الرؤية أو الإمكانية التأويلية للنصوص المحملة بالرموز ، والمتكئة على مخزون معرفى تاريخى يكاد من شدة تناظره فنيا مع الواقع المعاش جعل عملية التأويل والإسقاط متتابعة وباستمرار طوال النص، وبكثير من الإندياح الإيجابى فى غواية السرد .
وقد يكون بخلاف ذلك في الكثير من الأحيان أن القارئ يؤسس لرؤية تتجاوز رؤية النص، لكن تشظي البيئات والأزمنة وتداخل الحوارات ضمن أنساق لغوية أفقية وعمودية يجعل من لحظة الإمساك بزمام القراءة والاكتشاف لحظة عصية في المحاولة القرائية الأولى، وهذا ما ميز تلك الرواية وعلى وجه الخصوص تلك المسحة التي تضفي نوعاً من الاحتفالية المتكررة في كل مقطع أو فصل من فصول الرواية.
يشكل أحمد صبرى عالما من الصعب الفصل فيه بين ما هو واقعي وما هو متخيل، لانه يكتب عادة ما يعرفه او ما تراه عيناه ولكنه يكتب ايضا ما يريد ان يستكشفه وما لا يعرفه. لذلك فهو يبدأ أحيانا مما هو واقعي في نقطة ما او مكان ما او شخصية ما او تجربة ما او حادثة او احيانا مجرد عبارة، لكنه ينطلق منها ليبني عالما آخر يبدأ، بالنسبة اليّه، بشكل ضبابي غير واضح المعالم ثم يتبلور تدريجيا. وأحيانا يبدأ من شخصية غائمة بلا ملامح واقعية رسم لها بعضا منها فى التقرير الروائى الذى افتتح به هذا السفر، أو جذب لها عناصر من سيميائيتها التاريخية ،ولكنها تلح عليّه كحاجة للكتابة ، ثم رويدا رويدا يصير لها ملامح ورائحة وعالم واقعى حداثى ، وتصير قريبة الى درجة تسكنه كليا، وقد بدأت بالتبلور على الاوراق.
ولعلّ البناء الروائي في الروايات الجديدة كلّها يقوم على أن الحدث الذي نتلقاه من وعي الشخصية الرئيسية ينطوي على رحلة بحث عن المعنى لها بدايتها الحاسمة المحدّدة ونهايتها الحاسمة المحدّدة. وأحمد صبرىفي هذه الرواية ، يحطّم الفاصل بين الحقيقة الداخلية للشخصية وبين الحقيقة الموضوعية ، بين الوهم وبين الواقع، بين الحلم والحقيقية الموضوعة، بين حقيقة الشخصية وحقيقة غيرها من الشخصيات في تفاوت يختلف من صورةإلى أخرى، وجانب منها يغلب الآخر أو يعادلـه، يصالح بين طرفي التناقض في رؤية الكاتب لا رؤية الشخصية الرئيسية،. أنّ هذا الإحساس يرجع إلى تتبّع الكاتب لمجرى شعور أصل باىبشكل يغلب فيه على تتبّعه للأحداث الخارجية، "بل إنّ الأحداث الخارجية ذاتها تكوّن وتتلون بمجرى شعور الشخصية الرئيسية . وتركّز على استعمل هذا الأسلوب بل إنّ خلاصة دراستها أنّ أحمد صبرىقد تتبّع مجرى الشعور في هذا الرواية بشكل جديد وجيد. وهذا ما أشرنا إليه :أنّ أسلوب الروائي في (جمهورية الأرضن ) يقوم على "الإحساس بتطور الحدث من خلال انسياب مجرى الشعور عند ورد الخال وسيد الارضين وننوس عينها ، وهى تسميات بما جلبته من التاريخ من دلالات ، فالثابت فنيا فى هذه الرواية الدلالات الأيديولوجية التى يعنيها السارد ، وهو المتخذ فى الواقع سلفا موقفا وموقعا من حركة شخصيات روايته . بدالها التاريخى أو الحديث الواقعى ، وامتداده في فيض متصل يجمع الماضي والحاضر ويشير في الوقت نفسه إلى المستقبل . ومن المتعارف عليه أنّ مجرى الشعور يعتمد على "تسجيل الانطباعات بالترتيب الذي تقع به على الذهن، متجاوزاً في ذلك منطق الواقع الخارجي الذي يخضع ترتيب الأحداث فيه لعالمي الزمان والمكان... وهذا الأسلوب هو البؤرة التي نرى من خلالها تطور الأحداث ، أو الفضاء المحدد سلفا فى جغرافيا السرد ، كما تقدّم بنا هذا الحدث، وهو القرار الذي تلتقي عنده أحاسيس أصل باى ، وننوس عينها، وسيد الأرضين، وورد الخال ، وغيرهم من الشخصيات ، والتى لاتكاد تتفرد واحدة بالاستحواذ . ويؤكد هذه المقولة أنّ المبدأ الأساسي الذي ينظّم مجرى الشعور هو توارد الخواطر الحر، وأنّ هذا التوارد تحدّده ثلاثة عوامل هي الذاكرة، والحواس التي ترشد الذاكرة إضافة إلى المخيلة التي تحدّد مدى مرونتها، وكلّ هذا يجعل مجرى الشعور دائم التجدّد فى مسار رسم الشخصيات على كثرتها وتداخل أنساق حركيتها الروائية والشعورية ، ولا يحكم مجرى هذا الشعور ترتيب منطقي، ولا يحدّده زمان ولا مكان فاختلط فيه الماضي بالحاضر وبالمستقبل أيضاً. ، وقد استعمل أحمد صبرى المونولوج الداخلي غير المباشر، الذى يتوارى خلف تقنيات السرد التقليدية لتتبع مجرى الشعور هذا.
الواقعى برسم المكان التاريخى
وإذا نظرنا إلى النص من زاوية بناء الأحداث لوجدنا أنه بناء متتابع . فالوقائع تسترسل متعاقبة ، زمنها خطى يبدأ من نقطة وينتهى عند اخرى ، فلا تتداخل الوقائع فيما بينهما ، لكن هذه الوقائع تعرض من منظور الراوى طبقا للنسق الذى تحدث فيه فى الواقع ، وهذا نسق تقليدى ، ثبتت ركائزه الرواية التى أرادت أن تلعب دور التاريخ لواقع أكثر قساوة من واقع تاريخى ايضا اتكأ عليه السارد ، وكما اكدنا من قبل فالراوى ينطلق من فرضية كونه شاهدا وغير محايد على الأحداث ، أو عاكسا الواقع ، ولذلك فإنه يعرض تلك الأحداث على المتلقى متعاقبة ، متوازية فى الواقع ، وفى والمخيلة الروائية .
وبما ان المكان ( سيدة الأقواس التسعة،وقصر العدالة،وقاعة الشعب منه ، وفى تا محو، تا شمعو.......) هو الفضاء المؤطر لتلك الأحداث فقد تم التركيز عليه كمجال للحركة ولمرور االشخصيات وقد اهتم الراوى بتفصيل معالمه .
وإذا كانت العناصر الفنية المكونة للنص ( الشخصيات + الأحداث +الزمان + المكان ) لم تتفاعل بحسب الطرق الشائعة فى السرد الكلاسيكى ، فإنه برغم من ذلك وجد ت ذروة فى الأحداث وصراع وعقدة وتدرج ونهاية منطقية ، ولم يغب عن السارد إدراج بنية سردية أخرى جديدة . قوامها عرض شبه محايد لعالم تشكل من تضافر الذاكرة والمخيلة . (الذاكرة أنتجت الجزء السيرى فى النص ، والمخيلة أنتجت الجزء الروائى فيه ) ، وقد اقتضاه ذلك توظيف عناصره الفنية توظيفا جديدا ، بدءا من الاستهلال الذى قد لا نتفق مع السارد فى ضرورته ، وإن كان يمثل عبئا على المتلقى الكسول، مضافا إلى عبء التعامل مع هذا النص المشبع بعلاقة مشتبكة بالتاريخ.إلى أن استقام له طريق السرد الذى خدم حاجة النص ، فجاءت بنيته مفتوحة قابلة للاستنطاق والتأويل بحسب القراءة النقدية ونوع مقاربتها للنص ، ونراها تشترك مع نصوص شكلت فى الأدب العالمى نوع سردى جديد . يسمى أدب الديكتاتورية ، نحسب أنه قد استأثر باهتمام كبير كما سيستأثر باهتمام أكبر فى المستقبل . ذلك أن مثل هذا التخيل السردى الذى قدمته ( جمهورية الأرضين ) أصبح أكثر ميلا لدمج الرؤية الذاتية للأحداث بأبعادها المختلفة بالرؤية المتخيلة وبأبعادها المختلفة أيضا .
بأي أداة رآها الكاتب أنسب، وبالحس والانفتاح على المحتمل الذي هو أحد ألوان التخييل الذي لا بد أن يرقى إليه السرد الفني؟ نظن أن أحمد صبرىناور على الإجابة عن هذا السؤال مسبقا، وذلك بفطنة الروائي الذي راهن على شيء، بوعي أن الرهان قابل للربح وللخسارة في الآن عينه، وهو يضع نفسه، عمله، على مشرحة وفطنة وعي المتلقي، ويخضع لإواليات تلقيه. يتعلق الأمر في كل عمل محكم باستراتيجية خطاب، يشمل عند الكاتب سلسلة أعمال في عمل واحد. وكما لا يوجد أي كتاب من عدم، فإن روايتىأحمد صبرى ( طائر الشوك ، وجمهورية الأرضين ) متكافلتان، سواء بالرؤية وطريقة عرضهما أو بمحاولة الانقطاع عنهما والانزياح فنيا. وفي ( جمهورية الأرضين ) تشتغل الاستراتيجية على حدود القطع مع ماض نصي، وبمتاخمة حقل جديد على الكاتب وها هو يحمل متاعه وعدته ويباشر الانتقال إليه، خطوة، خطوة. لقد كانت (طائر الشوك )مشتعلة بحرائق النسيان والتطرف ونكران الماضى الناصع ، مسالكها وسماؤها مقفلة بالجثث، وبها شخصيات تداس أو تنتهي إلى الفقدان، فلا أمل. كانت الرؤية فجائعية، ومهما سعى السارد إلى إحكام قبضته على مفاصل المبنى الحكائي وإبرازالرؤية من المنظور الواقعي، وفي التشخيصات الأشد فداحة، فإن منبع الخطاب ذاتي، أي شعري، يقع قريبا جدا من نيران الحرب اللافحة، ولذلك جاء قسم غير قليل منه، في صورة أشلاء ولوحات هي لواعج القلب ونشيد الوجدان، في مرثيات للذات والآخرين على صهوات لغة مطهّمة بأصناف المجاز.
تسمى هذه الظاهرة الوجدانية والتعبيرية ب(الغنائية). في آخر كتاب له يعرّف ميلان كانديرا الغنائية بكونها: (تعيّن طريقة ما في الحياة، وأن القطب الغنائي، من وجهة النظر هذه، لهو التشخيص الأمثل للإنسان المفتتن بروحه الخاصة، وبالرغبة في إسماع صوتها) (Le rideau الستار، باريس، غاليمار، 2005،. ويضيف كانديرا، وهو في كتابه هذا يتحدث عن الرواية أساسا، بأن (الروائي يولد من أنقاض عالمه الغنائي) ، أي كيف أنه من هذه اللحظة يشرع في إحداث تحول في كتابته يمس جوانب جوهرية، وهو ما يعتبر عنده بمثابة اعتناق لمذهبية جديدة (لا غنائية) وقد أصبح فجأة على مسافة مما كان فيه أو عليه. لا نأخذ هذه الأقوال بحذافيرها، وإن كنا نستفيد من الخبرة والتجارب المنبنية عليها، وفي سياقها نضع رواية ( جمهورية الأرضين )التي بقدر ما يهتدي فيها صاحبها بتجربته الخاصة، والمتفردة في أكثر من ناحية، ينزع في الآن عينه إلى قدر أعلى من النضج بتجاوز الغنائية التي هي مرتبة، ولا ينبغي النظر إليها كمثلبة بالضرورة أي، كعدم نضج، كما يميل إلى ذلك كانديرا . وبما أن تغييرالاتجاه أو المذهب أشبه ما يكون بالردة بالنسبة للمؤمن ترى رواية أحمد صبرى الثانية كأنها في المنزلة بين المنزلتين بين عالمين وأسلوبين، وفي سبيل السيطرة على العالم المرصود بأزمته،
أزمة الولع بالسلطة لحد الجنون والتهتك ، وفىالقبض الكلي على ناصية الشخصيات والسرد وكل شيء، فإن ضمير المتكلم، البطل والسارد، ومعه تلك الرغبة الحارقة لقول الأنا (غنائيا) يتحول إلى شرك يقيد منزع التجربة الجديدة إلى اللعب القديم ويشوش على رؤية وإيقاع الإنتقال. لكن، ليس بوسع الكاتب أن يضمن شيئا من البداية، وهو روائي حقا لكونه وهو يكتب، ، يتحرر من المسبق والتأويل الجاهز. يبحث ويكتشف ليجد أمامه الرؤية لا الموضوع، والخطاب لا التيمة، والفن أكبر من أجناسه، ونظن أن هذا يسمى عند أحمد صبرى، وعند كل كاتب موسوس بإبداعه، امتلاك الأجنحة للتحليق في فلك الجدارة الروائية، وهي، أيضا، مقامنا الحرب التي أرسل ثربانتس دون كيخوته ليكسبها، وما تزال جبهتها مفتوحة بتوالي الفرسان فى أعقاب أحمد صبرى.
********************
شارك الباحث بهذه الدراسة فى مناقشة العمل المذكور بفرع اتحاد الكتاب المصرى بطنطا يوم الأحد الموافق 21/8/2005











.jpg)













































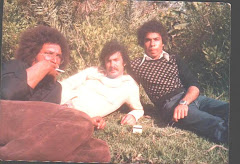













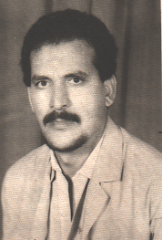









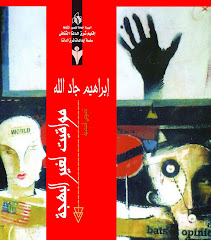

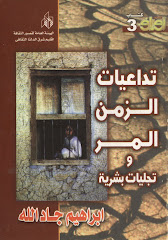









.png)









-001.jpg)











ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق