
ثقافة الجهل
لا تنفر ـ عزيزي القارئ ـ من التناقض الذي يبدو في هذا العنوان. فللجهل ثقافته حقاً، وهي واسعة الانتشار وشديدة التأثير في حياتنا، بل إنها الأكثر فاعلية في تحديد المواقف وحضوراً في السلوك اليومي.
التناقض أنواع، والتناقض الذي يبدو في هذا العنوان هو غير التناقض الطبيعي الكامن في كل ظاهرة أو تكوين، والمولّد للحركة الدؤوبة في الطبيعة والإنسان والعلاقات الاجتماعية المختلفة.
التناقض في هذا العنوان زائف ومتوهَّم، فالظنّ السائد هو أن الثقافة نقيض الجهل، ولا يمكن أن يجتمعا، لكن المراقب المتابع لما يراه يجد أن ثمة ثقافة تقف وراء كل سلوك جاهل، فاسد ومؤذٍ، ثقافة تصوّره على أنه السلوك الطبيعي الموافق لمقتضى الحال، والمعبّر عن صلابة صاحبه وحرصه على المصالح العامة وغير ذلك من مسوّغات يقبلها الكثيرون.
للجهل ثقافته، وثمة من يروّجها على نطاق واسع، إما لأنه مقتنع بها حقاً، أو لأنه يجد فيها سياجاً لمصالحه ونفوذه. لكن حامليها والمتأثرين بها هم في أغلب الأحيان من الطيبين الأنقياء، الذين حدّدت العواطف نشاطهم العقلي، وقتل التسليمُ بالموروث والمألوف كلَّ نزعة للتفكير الحر المستقل لديهم، وخلعوا على المتنفذين عباءة الثقة، وارتضوا أن يكونوا منقادين لمن هم أكثر قدرة على التلاعب بالألفاظ والمشاعر والعقول.
للجهل ثقافته، والمؤسف أنها أصبحت بنية عقلية راسخة تتجلّى لدى كثير من المثقفين والكتاب والسياسيين، كما تتجلى لدى عامة الناس، ولا تستطيع إخفاءها تلك الغلالة الرقيقة من الكلام المباح عن العقلانية والموضوعية والإنسانية والديمقراطية وغير ذلك.
نستطيع ذكر بعض جوانب ثقافة الجهل هذه، دون أن نضرب الأمثلة ونستخدم الشواهد، فكلّ مدقّق فيما يجري حوله، على مختلف المستويات، يستطيع أن يجد ما يبرهن ذلك ويؤكده.
ولعل من أبرز جوانب ثقافة الجهل، روح العداء والنفور، هذه الروح التي تشكل قاعدة لسلوك كثير من الناس من مختلف الفئات والطبقات، ولا أستثني العاملين في الحقول الثقافية والسياسية.
النظر إلى الآخر بحذر، وافتراض العدوانية في مواقفه وسلوكه، والتوجس مما يمكن أن يفعله. النفور من كل جديد غير مألوف، ومعاداة من يطرحه أو يفعله، والتمركز على ما درجنا عليه من عادات وقيم، والخوف من الابتعاد عنها أو اختراقها. الخوف على ماضينا من جموح عقولنا ونزعاتنا، والتسليم بما هو سائد، والشكّ من جدوى العقل والتفكير. ألا نجد ذلك كله على نطاق واسع؟ وكم نسبة الذين يمكن استثناؤهم من المشبعين بثقافة العداء والنفور هذه؟
ثقافة رفض الآخر، وازدراء فكره وتجربته والسعي إلى حرمانه من التعبير عن ذاته، فكراً ومصالح وتطلعات.
الثقافة التي لا تقرّ بالاختلاف، ولا تعطي المختلف حقوقاً مساوية لحقوق الذات، وتنظر إلى المختلف بوصفه عدواً لا بوصفه آخر مكمّلاً ونقيضاً ضرورياً وندّاً ناقداً ومقوّماً.
ثقافة اليقينية التي تتوهّم امتلاك الحقيقة والبراعة المطلقة في التعبير عنها، الثقافة التي يقول حاملوها: نحن على صواب دائم ومطلق، أما الخطأ فهو عند غيرنا الذي عليه أن يتعلم منا ويتقرب إلينا تقرباً من الحقيقة.
ثقافة المفكّر الذي لا يرى الصواب إلا في منهجه ولا يجد المختلفين عنه إلا مبتدئين أو ضالين.
ثقافة المؤمن بمذهب أو عقيدة، فيحوّل إيمانه إلى قيد يمنعه من التواصل مع الآخرين مهما يكن اختلافهم عنه صغيراً.
ثقافة المتحزّب الذي يثق بما تعلنه قيادته ثقة عمياء، ويأخذ بما يملى عليه دون شك أو تدقيق أو مناقشة، وينظر إلى غير الحزبيين أو المنتمين إلى أحزاب أخرى نظرة المتعالي الواثق من أنه أكثر صواباً وإخلاصاً.
ثقافة الحزبي الذي ينسى أن رفيقه الذي يختلف معه في الرأي يظل رفيقاً له، وله الحق في الوجود إلى جانبه، لأن في التنوع قوة ونموّاً.
باختصار، ثقافة العداء والتعصّب والتسليم باليقينية والأحادية، هي ثقافة الجهل، هي المناخ الملائم للسلوك المؤذي، وهي جرثومة هشاشة المجتمع وضحالة الفكر.
هذه الثقافة كانت موجودة على الدوام، وكانت سائدة في كثير من المراحل، ومن يعد إلى التاريخ يجد أن سيادتها لم تؤد إلا إلى التعثر والتراجع والتفسخ، وهذا ما طبع مجتمعنا العربي عامة قروناً عديدة.
لكن كل زمن، كان يشهد ظهور عدد من المفكرين والمثقفين والسياسيين، يواجهون التيار ويعرّضون أنفسهم وأرواحهم للخطر، وهم يحاولون خرق جدار ثقافة الجهل، ويسعون إلى إخراج جمرة العقل المفكّر الجامح من رماد التسليم واليقينية، ويعملون على هزّ الثوابت وتحرير أجنحة المجتمع، وما كانت جهودهم وتضحياتهم تضيع هباءً، فعلى الرغم من أن تأثيرهم ظل محدوداً في زمنهم، غير أن ما طرحوه ويطرحونه كان يمثل الوجه الآخر المشرق الذي ستقوم عليه عافية المجتمع المنشودة.
انتشار ثقافة الجهل، وتمكُّنها من عقول الكثيرين من الناس، ومنهم غير قليل من المثقفين وذوي النفوذ السياسي والديني والاجتماعي، هو اللاجم الأقوى لنهوض المجتمع وتقدمه، وهو العدو الأخطر، لأنه كامن في الذات، ومُرتَكَزٌ يستند إليه ويستفيد منه العدو الخارجي. ولأنه كذلك، فإن أي نجاح في زعزعته هو خطوة إلى الأمام، وأي تقوية للثقافة العقلانية الديمقراطية التي تقوم على نزعة التواصل بدلاً من النفور، والشك بدلاً من التسليم، والاعتراف بالآخر وحقوقه بدلاً من إلغائه، والتعددية والتنوع بدلاً من الأحادية، هي تقوية للمجتمع ومعالجة لهشاشته، والوسيلة الأهم لدفعه باتجاه النهوض والتقدم.











.jpg)













































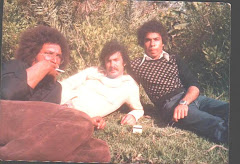













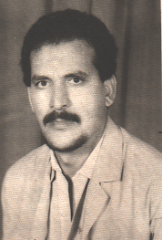









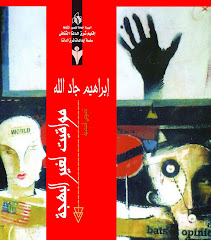

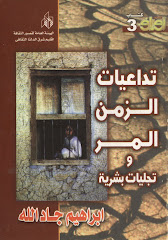









.png)









-001.jpg)











ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق