
ِِمر الذي مر.لكنها أشياء باقية في الذاكرة ، وفينا
محطتان بالعمر. واحدة للحزن ، وأخرى للفرح ، والإثنتان للكتابة
مقتطفات من شهادة ادبية طويلة تصدر قريبا فى كتاب بعنوان ( سنوات الاشتعال والانطفاء ) قدمت فى مؤتمر ادبى بمدينة كفر الشيخ بمصر فى 2\4\2006
***********
الكتابة شهادة، وعندما لا تكون كذلك، فإنها تصبح أي شيء، إلا كتابة.
لا تكون الكتابة شهادة إن لم تكن صادرة عن شاهد بالحق.
الكتابة التي لا تكون شهادة هي كتابة ظالمة، وناقصة، ومتواطئة.
الكتابة هي أن يكتب الكاتب ما يراه، وأن يشعر بما يرى، وأن يعجنه بدمه ويجففه بعرقه، وأن يكون ما يكتبه صرخة مدوية، تصل إلى الآخرين، ويوصلها الآخرون إلى الآخرين.
وكثير من أنواع الكتابات هي سحابات صيف عابرة، لا ماء فيها ولا روح، جسد ميت، التراب أولى به.
لأن فعل الكتابة اليوم أصبح ترفا، ولم يعد مسؤولية.
والمسؤولية من السؤال: من أنا؟ ولماذا أحمل القلم؟ ولمن أكتب؟ ولماذا؟
لا أحد يطرح هذه الأسئلة اليوم إلا قليلون.
لهذا تكثر الكتابات ويقل المعنى، لهذا سقطت قيمة القلم.
القلم حياة، والقلم موت أيضا، والقلم جسر بين الحياة والموت، يمر منه سالما من كان شاهدا بالصدق، لا متسليا، ولا طالب منزلة، أو باحثا عن الأضواء.
أقسم الله سبحانه بالقلم في سورة تحمل إسم هذه الأداة العجيبة:''ن. والقلم وما يسطرون''.
وقال محمد جواد مغنية في تفسير الآية، والقسم الإلهي بالقلم:
''أقسم به سبحانه لعلو شأنه حيث لا إنسانية ولا حياة إلا به''.
وفي الكتابة الحديثة يكثر الكلام ويغيب القول، لأن الكلام هو أي شيئ، ولأن القول هو الذي يملك المعنى.
والسبب أن الإنسان فقد الارتباط بالقيمة العليا التي جاءت به وستأخذه غدا.
قيمة المعنى الذي يمنحه لحياته.
قيمة الموت، وسؤال ما بعد الموت.
الكتابة الفارغة من المعنى، هي أيضا تغييب للآخرين، وعدم منح الاحترام الواجب للناس، لأنها استهتار بهم، وسخرية منهم، واستغفال لهم.
ولهذا فسدت الكتابة اليوم، لأن الكثيرين لا يعرفون ما يريدون منها، فلا يفهمهم الناس، لأنهم هم أنفسهم لا يفهمون أنفسهم.
يقول بعض الحداثيين: أنا أكتب للمستقبل، وللأجيال المقبلة التي ستفهمني.
رجل كهذا ينبغي أن يكون أحمق.
لأن المستقبل ليس عاقرا، والأجيال المقبلة ستكون لها مشكلاتها، ولغتها، وكتابها، وفنانوها.
إذا لم يفهمك الذي معك، لن يفهمك القادم.
هذا هروب من مواجهة المشكلة، والهروب من مواجهة المشكلة مشكلة ثانية.
الكتابة الحقيقية تضم الحاضر والغائب، تشهد على الحاضر، وتتجذر في الماضي، وتتشوف للمستقبل.
أولا :
شيء ما في القبر
في وقت الأعياد نتذكرهم حتى ولو أرادت الذاكرة أن تنأى عنهم لأسبابها التي قد نغفلها او لا نفقهها. نعاندها أو لا نفعل. نتذكر وجوههم تفصيلا بعد تفصيل ونحّن إليهم ونشتاقهم.
أكثر الأوقات شدة وأكثرها فرحا، ناعمة كانت أو خشنة، تستدعينا للقائهم. ذهب الحاضرون في حركاتنا وانفعالاتنا وحبنا وكآبتنا... ذهبوا بالفعل. وما زلنا نشتاق لنقول لهم كم أحببناهم وحتى ولو لم يسألوا، هل فتحنا محراب الكلام بيننا؟ هل طلبنا أن نغفر لهم أو يغفروا لنا؟ ماذا قلنا لمن رحل وقد كان جسراً وسؤالا ومهواراً وخيمة وقوة وخوفا وأغلالا وأمانا وخيبة احيانا... ذهبوا... كيف لنا بلقائهم؟
العيد الذي كانوا فيه ، العيد آت من جديد... فكيف نفرح وهناك كل هذا الافتقاد لهم... قد نعيّد افتقادهم. قد نعيّد ما كان حاضرهم أو نرثيه... نذهب الى قبورهم ونستجديهم بأن يستحضرونا كما نحب أو كما يحبون، كما لو كان اللقاء عيداً. أو نستحضرهم لأننا نشتاقهم ونستفقدهم ونريدهم معنا؟ ولكن هل يا ترى... ألا نعكر عليهم صفو كينونة يعيشونها بشكل آخر؟ هل هم يريدوننا من جديد؟ أين هم الآن؟
قد نفكر أن نذهب جماعة، كما في لوحة ماتيس (الاتحاد)، ونرقص حبا ومشاركة حول قبورهم أو حول ذاكرتهم. قد يشاركوننا توقنا لملاقاتهم أو لا يفعلون. باتوا في مكان آخر... في صقيع أو دفء، في سلام أو حسرة، في رونق أو ذبول، في نور أو ظلمات، أو في لا شيء... كيف تساعدنا الحياة على موت الأحبة دائما... كما لو انه دوما قبل الأوان؟
هى ليلة فارقة فى عمرى مذ وعيت ، ليلة كل عيد
والعيد غدا، نريد أن نعّيد ونعيد معهم ولو غابوا ، لعل من لقاء موجز. إعادة لمّ شمل، أي لقاء معهم في العيد نستكين له ويستكينون.
حول القبور، في المساجد، أو حول الأضرحة، يجتمع الأحياء جماعة ومنفردين، وخاصة في المناسبات، في أعياد الفطر والأضحى عند المسلمين، وفي عيد تذكار الموتى عند المسيحيين، وفي <<رأس السنة اليهودية>> عند اليهود، وفي عيد <<اوبون>> عند البوذيين، الخ...، لزيارة من رحل من أحبائهم أو أنبيائهم أو أوليائهم.
كنت اتساءل دوما :هل يأتى هؤلاؤ الأهل بدافع واجب ديني، أو للذكرى، أو لأنهم اشتاقوا لالتماس استمرارية صلة، للدعاء، للتكفير او للتطهر؟ ومن لا يزورها، هل لا يستذكر من رحل، أو لأن الذي ولى قد ولى ولا حول ولا قوة الابالله؟
لحظة وفاء
نحن توارثنا عادة زيارة القبور وأخذنا نمارسها دون التفكير فيها، ، كنا وقت الأعياد نرتدي أفضل ملابسنا ونذهب قبل شروق الشمس صبيحة العيد لزيارة الموتى وقراءة القرآن قرب مدافنهم، وكانت العائلة بأجمعها تجتمع هناك. لذا اقترن العيد في أذهاننا بزيارة القبور التي تجمع العائلة جميعها، وكنا نحن الأولاد نشعر بالفرح، إذ ترانا العائلة في ثيابنا الجديدة. هذه العادة أصبحت فيما بعد لحظة وقوف من الحزن أمام قبر العزيز على قلوبنا قبل بدء الاحتفال بالعيد. إنها ذكرى ولاء لمن نحبهم. إنني أؤمن بقراءة القرآن قرب القبور ليس لأن الروح موجودة أو ليست موجودة، إنما لأننا عرفنا قبل موت أولئك الأشخاص، من خلال ممارستهم أمام قبور أحبائهم، إنهم سيكونون مسرورين بهذه الزيارة، وأنهم يتوقعون من أولادهم القيام بمثل هذه الزيارة. بالرغم من أنني لست على يقين أن روح الأحبة ستسمع دعواتي وقراءاتي. إن القراءة، بحسب القرآن تصل إلى الروح من أي مكان كنت به. ربنا كفيل بتوصيلها حيث تكون الأرواح، إذ نحن لا نعلم أين هي تعوم. ولكن عندما اذهب إلى الضريح أشعر بقرب أكثر، إذ هناك يركن الجسد الذي كان. ولكن لا اشعر إنني أريد أن أتحاور مع الموتى، بل اهدي فقط سوراً من القرآن لهم لكي يخفف الله عن ذنوب أحبائي>>.
حديث إلى القبر
ومازلت لحد هذه اللحظة فى موضع التساؤل : هل تعرف الأموات زيارة الأحياء؟ <<ما من مسلم مر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلاَّ ردَّ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام>> (النبي محمد صلعم).
لكن زيارة القبور كانت ومازالت بالنسبة لى حالة وجدانية بما فيها استعادة لذكرى الأحباء، ، وأنا نشأت على عادة زيارة القبور ، وكنا نغرس قبور الأحبة بأحبال مجدولة من عيدان الصفصاف الخضراءعشية العيد، ويو م شم النسيم انها شجرةمصرية بامتياز ومن ثم تأتي العائلة بأجمعها، صباح العيد ونجتمع حول قبر آخر شخص فقدناه، ونوزع المعمول على الفقراء، ويهنئ أفراد العائلة بعضهم البعض حول هذا القبر ومن ثم يتوجه كل واحد نحو قبر الأقرب إليه.
من منطلق إيماني، اشعر عند زيارتها بهذا التواصل النفسي الداخلي مع أحبتي لأنهم ما زالوا في ذاكرتي، وأتمنى أن يزورني أحبتي بعد مماتي لكي اشعر باستمراريتي بين الأحياء.واوصيت زوجتى بذلك ، وقد لا حظت ما طرأ على سلوكها من تحول جذرى ، من رفض لزيارة القبور، وقد علمت انها تجالس زميلات منقبات لها اثناء ساعات العمل الرسمية ، وذكرتها بحديث شريفعن النبى محمد ( صلعم) : <<كنت قد حرمت عليكم زيارة القبور ولكنني الآن أقول لكم أن تذهبوا وتزوروها لأنها تنعش القلوب، وتجعل العين تبكي، وتجعلكم تفكرون بالآخرة وبالدنيا...>>،.
<<عندما أتضايق من أي أمر وأشعر بالاختناق منه، لا أبوح به الا قليلا لزوجتي أو لأولادي، لكنى اذهب إلى قبر أبي وأحدثه عنه، فأبى في حياته أو في مماته يمنحنى الراحة، فكلما وصلت إلى مفصل صعب في حياتي يحتاج إلى قرار أرى أبي في منامي ومن مجرد ظهوره استمد القوة. ومن الملفت أن كل كتابة مندفعة في جريانها، وجادة في مدلولها أمارسها بعد العودة من القبور مباشرة ، ولعدة أيام متوالية ، هل هي الرغبة بأخذ الحياة قبل أن يدهمني الموت ؟ ، هل هى مقاومة لتلك العبثية التي راجت في أفعالي بعد مرض الولد الوحيد الذي سيطول ، أو الذى لن ينتهى سوى بموته ؟ ، هل ، وهل ؟ ، ولكن الإجابة أظل دائما فى غنى عنها ، لأن أبى قال لى على أرصفة المرارة من الحياة دائما : أطلب من الله دائما أن يعطيك ظهرا قويا ولا يعطيك حملا خفيفا ولكن الزيارة التي اندفع إليها لا إراديا ، وفى كل مرة ، هي إلى قبر << نادية >> التي كانت رفيقة أيامي المتوهجة بالشباب وحب الوطن ، التي ماتت في قبو بارد في سجن من سجون نظام السادات ، أزورها لأشعر أمامها بالخذلان أنى تركتها تذهب ونجوت أنا بنفسي ، برغم أن ذلك تم بمعجزة كبيرة ، والغريب أن قبرها يقع على مرمى بصري يوميا ، فلا يحتاج الأمر لمناسبة للزيارة .
تمت نجاتى من الموت ، لأنهم خيرونى بين انفصالى عنها فى الدنيا فقط ، ام انفصالنا فى الدنيا والآخرة ، ولم اكن أعى هذا السؤال حقيقة ، فظننت ، وكل الظن اثم ، انهم يودون ايثارى بالترحيب المشهود لهم به ، لتخفيف عبء الكرم عنها ، وقد قالت لهم أن قلبها يوجعها ، ولما صفعها صاحب الثلاث نجمات وهو يقول : قلبك يوجعك وتظلى شيوعية لا تؤمنى بربك ؟ ، كنت ساعتها قد ابعدت الى حفل آخر ، ولم اشاهدها غير جثمان ملفوف 0
هى محطة لم استطع للحظتى الآنية الاقتراب منها ، او مجرد تلمس الحروف لصوغ ملامح منها، فأغرق راسى فى الكتابة مع ناس قريتى ،كمعادل موضوعى عن الأسى، وأواصل التوحد مع المتوسلين بوهج الكتابة فى المدن العربية ، كتابا وشعراء وصعاليك
<< وفى زيارتي لقبرها حاجة نفسية وضرورية ، تشعرني بالأمان الداخلي وبأن الحبيب هو حي بعد وفاته، فلا يشعر بأن الوفاة هي النهاية فينتهي احد أسس إيمانه وهو أن هناك بعثا بعد الموت. من لا يزور قبر أحبته يعتقد أن الموت هو النهاية>>. وفى كل مرة أشعر أن زيارة قبرها كما تمت بالداخل أيضا فقد سكنت الخارج فى ، فاندفع الى الكتابة أيضا ، ملبيا رغبتها التى لم تر من آثارها شيئا ، وهى أن ترى أول غلاف لكتاب لى
هناك أخاطبها لمواساتها والأصدق ربما مناداتها هي لمواساتي. تواصلي معها فعل اشتياق وفعل ندامة وفعل اعتراف ومعاتبة، لأنها تركتنى ألملم بهجتى بكل غلاف كتاب جديد خزيا ، لأنها لن تراه ، ودائما فعل حاجة ملحة لوجودها قربي. ، ولكن ولسبب ما اعتقد أنها متفوقة وأكثر شاعرية ونقاء وصفاء منى، وهناك من إله ، هى حتما سبقتنى اليه.، ولاترقب مجيئى ، وأسمع داخلى يرن بصوتها : أن أعمل وكأنى أفرح بك
الآن، وبعد مرور سنوات على رحيلها، حين أمر بالقرب من تلك المقبرة التي رقد جثمانها بها، بين المئات وربما الألوف من البشر، اذكرها وأتلوا آيات صغيرة وكلمات كانت تحبها لبابلو نيرودا ، وأغنيات كانت تدندن بها لصالح عبد الحي ، وبخاصة أغنيته الخالدة << غريب الدار 0 عليا جار >> .، ولسبب ما كانت تكره أغنيات يكتبها أحمد فؤاد نجم ، ويغنيها الشيخ الضرير إمام عيسى ، وحين صار على امتلاك جهاز حاسوب ، وقررت ادخال أغنيات الشيخ عليها لم أتجاسر مرة واحدة على سماعها . والان بعد ان نكأت جرحا تخثر الدم على اطرافه ، لا بأس من الجلوس على شاهد قبرها وكتابة تلك الرحلة الارتجاجية لجيلنا .
لطالما كنت مفتونا بعالم الموتى وبسر الموت منذ الطفولة. عرفت الأمر باكرا عندما كنت تلميذا في مدرسة القرية. تعرفت حينها على هذا الطقس من خلال مناسبة عيد الفطر كما ذكرت سابقا. لقد كان لهذه الذكرى في ذلك الوقت هالتها وهيبتها وروحانيتها الخاصة بالنسبة لي على الأقل، أنا الطفل الذي شعر آنذاك بأنه صار يحمل سرا جديدا ومغزى آخر للحياة. كان الأهل ينظمون زيارة إلى المقبرة ولم يكن لي أي قريب دفن هناك، لكن ما إن وصلت المكان حتى شعرت أنني أسير على الغيم، وإنني عبرت من عالم الطفولة البسيط إلى عالم اشد طفولة وأكثر بساطة، وبغريزتي عرفت كم أننا ضعفاء. قرأت الفاتحة، وشاركت في الدعاء لنفس الموتى (الغرباء)، وأجهشت في البكاء حتى كاد يغمى عليّ، وظن الرفاق الصغار أن احد أقاربي مدفون هنا.
وثمة قبور لم ازرها بعد ، منها ماهو بعيد فى الجغرافيا ، كقبر صديقى محمد شكرى ، وقد اوصانى ان لا أفعلها ، وقبر ابنى الوحيد لأنه لم يقم بعد فى الجغرافيا ، وإن كنت آمل زيارته قبل ذهابى بجواره أو فى أحضانه ولو بساعة واحدة ، وهو وان كان ميتا حيا ، فتلك امنية تلعب فى تضاريس الكتابة اليومية ، لذا فأنا لا أكتب الا وحزن قوى يحركنى. وهذا ماجاءبالضبط كتمهيد لمجموعتى القصصية الأثيرة والقريبة الى ( من أوراق موت البنفسج)
الآن لم اعد بحاجة إلى زيارة القبور ورؤية الشواهد المنشورة في أرجائها. مضى زمن بعد ممارستي لتلك الشعائر. اخذ الموت أبي وأصدقاء وأحبة وكلهم ما زالوا في الوجدان والذاكرة. لا اعلم إذا كانوا يسمعونني. ما أعلمه ، ويقينا إن نادية التى قضت على ايديهم وأبى الذى كان يلاحق كتبى فى محطات التهريب على اسطح الجيران اتقاء سطوتهم ، يسمعانى ، فهما فقط من بكيا من أجلى في محن عابرة .، ووأخيرا أخذ الموت فتحى عامر وأطوار بهجت ، ولم أجرؤ على محو رقمى هاتفيهما من دفترى كما يفعل الكل ، لأن محو الرقمين محو للذاكرة.
<<لا يمكن لطقوسنا وأسرارنا الخفية أن تتغير، على عكس القوانين الضعيفة غير الأكيدة التي يضعها البشر>>، يقول فولتير. ويرى الأب بارثيلمي ان <<الطقوس شأنها شأن الدليل الذي يمسكنا بأيدينا ليرشدنا على الطرقات التي خطها مراراً. للأسف إن طقوسنا تختفي تدريجيا، ومعها كذلك في الدرجة الأولى السهر على الميت. إذ أن هذه الأخير هو الذي يساعدنا على إدراك أن أمواتنا قد ماتوا فعلا>>. وحين كنت غائبا فى ظلام ما ونادية تفارق الدنيا ،لم اسهر على موتها ، وحين سللت كفى من قبضة أبى ليلة احتضاره الطويلة باكيا ، لم أسهر على موته ، ولكنى الآن أسهر على موت المعنى الذى اتفقا عليه دون لقاء بينهما طال ، وهو أن يكون للإنسان معنى ووجود حقيقي بالحياة ، وان تكون قضية للإنسان ، أو أن يكون الإنسان هو القضية الكبرى بين سطور كتبي ، فإذا لم يكن الإنسان قضية 0 فما تكون القضية ؟.
مناسبة اجتماعية
<<انني اميز بين الدين كإيمان والتدين كتظاهرة، وأجد أننا آخذين بالميل اكثر فأكثر نحو الطقس وليس نحو الروح. فروح الدين هي العلاقة بالقيم. التصوف الذي يجعل الإنسان يراجع نفسه بما يحصل بشكل فكري ونظري أي عقلاني وليس بشكل طقسي. أنا لست طقسيا وآسف أن هناك ميلاً شديد عند البشر نحو الطقوس حيث تحول كل شيء إلى شكلي ومظهري لا يركز على الجوهر. وأنا ضد تحويل العلاقة بمن نحب إلى طقوس شكلية تحول دون التأمل الصوفي>>.
من المعروف أن كثيراً من العادات والطقوس تمتد جذورها إلى آلاف السنين ما قبل الميلاد، وإذا كانت قد تعدلت فهي ما زالت تتشابه إلى حد بعيد. في القرن الخامس قبل الميلاد كان السلتيون ((Celt يحتفلون بعيد <<جميع الارواح>> في 31 ديسمبر، إذ كانوا يعتقدون أن في ذلك الوقت يكون الغطاء بين الأرض والعالم الآخر رقيقا جدا، مما كان يسمح بأن يختلط العالمان ببعضهم البعض، كانوا يشعلون نارا كبيرة على تلة كي يضيئوا طريق الأرواح، وكانوا يضعون لها الطعام أمام أبواب المنازل كي لا تدخل إلى داخلها. وما زال اليابانيون البوذيون يحتفون بالموتى في عيد <<اوبون>> السنوي حيث يعلقون المصابيح أمام البيوت لتدليل الأرواح على الطريق، ويرقصون في المعابد، وفي نهاية العيد الذي تستمر طقوسه أسبوعا، توضع مصابيح عائمة في الأنهار والبحيرات، والبحور، لكي تستدل الأرواح طريق العودة إلى عالمها.
عندما وعيت، بدأت اشعر بأن الموت موحش وكريه. أن نستوحش من أحبتنا عندما يموتون. ولكني أؤمن أن الموت حق، وأننا كما أتينا إلى هذه الدنيا بدون خيار نرحل عنها كذلك من دون خيار>>.
صك وفاء وولاء
أزورهم لولائي ومحبتي ووفائي لهم، أريد أن أبقى على صلة بهم. وحول القبور يكون حال سبيلي كالآخرين الذين أتوا ليؤكدوا وفاءهم للسالفين، وتكون مناسبة اجتماعية للالتقاء بأناس لا تلتقي بهم الا وقت العيد حول المدافن. وأنا عندما أقرأ صورة ( يس ) بشكل خاص اشعر بأنهم يسمعونها، وأشعر في نفس الوقت بأن هذا الطقس علاج لي بمعنى انه يشعرني بالراحة النفسية، كما يكون شعوري عندما أقوم بعمل خيري أو إنساني. وكذلك فإنني اشعر بأنني ما زلت قادرا على التحاور مع أحبائي في قبورهم وأستذكر نظراتهم وكلماتهم، وأسر لهم بمشاكلي وأشعر بأنهم يوحون لي بحل لها، وبعد ذلك نعود إلى البيت بشعور باللذة والمتعة لأننا نكون قد ختمنا صك وفاء للناس الذين ولّوا وما زلنا نحبهم.
<<إذا مر رجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه؛ وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام بعضهم أرسل إليّ إشارات بأنه يعي ما أقول، ربما يكون الاتصال لحظتها في ذروته في المكان الذي يترك فيه الموتى آخر آثارهم... لمستهم الأخيرة على الوجود المادي المألوف، آخرون لا يؤمنون بذلك ويعتبرونها من دواعي السخرية والتهكم... ولكن شيئاً غير عادي يلف وجودك في مكان تسبح الأرواح فيه، يهدأون حين يعرفون أنك شخص هادئ، ويضجون بالحركة حين تظهر لهم اضطرابك... في السنوات الماضية توسع السكن ليضم المقابر ولتلتف المباني حول أسوار القبور، ولذلك أصبح عادياً أن يكون مشوارك اليومي ذهاباً وإياباً لا بد وأن يأخذك في عبور سريع على ضفة مقبرة. أحياناً أفقد ذلك الاتصال، ويصبح مروري مملاً واعتيادياً ولا معنى له... ولكن سرعان ما تستيقظ تلك الأصوات والمحاورات بيني وبينهم... لا شك أنهم موجودون الآن. الآن أزور قبور الموتى باستمرار... ولا أفعل ذلك في الأعياد بسبب الزحام الذي تشهده المقابر وقتها. أفضل أن أكون وحيداً في الجبانات والترب... مع مدينة من الشواهد المنتصبة كمبان تتحرك بينها الأسرار. غالباً لا أزور قبر صديق أو قريب... أتجوّل في المكان وكأنني مدعو من سكانه. أقوم بذلك، لأسباب بعضها روحاني... وبعضها له علاقة باكتشاف المقابر كانت جولاتي تلك تسبب لي المتعة... والدهشة معا... وغالباً ما أكون في حالة اكتشاف مستمر، وليس من الأمور المدهشة أنى استذكرت دروسي في الثانوية الأزهرية بداية سبعينات القرن الماضي وسط ترب<< سندوب>> بضاحية مدينتنا المنصورة..
وفى اليوم الذي سبق أحد الأعياد، عند الغروب، وكان جميع الزائرين، ذلك اليوم البعيد، قد غادروا قبل الغروب للاحتفال في العيد غدا، اذكر أنني رأيتها وحيدة لا عيون مرئية لها. مررت بها بصمت والرأس حان، سمعتها تقول، ربما ليس لي:، حفرت له القبر عميقا وكبيرا، وجعلت فوهته على مقاسه، سأنتظر بعضا من الوقت. علّه يخرج!
ثانيا:
...بعد أن انقضى العمر الذي لم أعشه
وهى ليلة أخرى ، تأتينى بلا طقوس أعتادها ، أو أسعى للقائها مرة، ولكنها دائما ما تنبهنى ، لأنى أعرف موعدها الزاحف كل عام ، إنها من بين المناسبات كلها تبقى أعياد ميلادنا ذات وقع خاص، فهي تضيف سنة وتنبهنا، إن كنا غافلين، إلى عمرنا الذي يزداد وحياتنا التي تتناقص. نستطيع تمضية عيد ميلادنا بشتى الطرق، السعيدة منها والتعيسة، لكننا لا نستطيع تجاهل ذلك الجرس القويّ الذي يُقرع منذ منتصف العمر، ومن أي سنة أحصيت أنا منتصف العمر ؟ وإذا صادف وأمضينا حياتنا في بلاد يحكمها الخوف فإن الإشارة المفزعة لعيد الميلاد هي: لقد أُهْدِرتْ سنة أخرى من عمرك. إذن هل يمكننا الحديث عن عيد ميلاد في ظل الأنظمة الأمنية؟
أبدأ بالقول: إنني، وبشكل مباشر، تعرضت لكثير من صفعات رجال الأ من. وصفعات قليلة كانت في البيت أو المدرسة، وهذه لا تجعل مني مناضلاً صالحاً أمام الكثير من أصدقائي المعتقلين السابقين. ، ولكنى أيضا و ببساطة شديدة واحد من ملايين تم استثناؤهم من الضرب بحكم المصادفة، ولاعتبارات منطقية وواقعية أيضاً. فأنا في الواقع لم أشكل خطراً على أي نظام، لم أفعل ما يستوجب الاعتقال والضرب، وشخصيتي الهادئة لا تبدو جذابة بما فيه الكفاية لمخبريه. أما استقلاليتي عن التنظيمات المعادية للنظام، بل ونقدي لها أحياناً، فقد ترضي هؤلاء المخبرين، دون أن تلغي تشككهم بي. فأنا أنتقد النظام أيضاً، وبقسوة في أحيان كثيرة وفي المحصلة أنتمي فى نظرهم إلى فصيلة الثرثارين المزعجين أحياناً، غير الخطرين فى أحوال كثيرة.
المصادفة أيضاً، أو حسن الحظ، أو كلاهما نجّياني مرات كثيرة من الاعتقال والضرب. فمؤهلاتي السابقة ليست كافية بحدّ ذاتها، طالما أن جزءاً ممن اعتقلوا لم يفعلوا شيئاً، بل اختارتهم يد القدر الأمنية لتربية الملايين من أمثالي. هذه ليست نكتة: أن يفكر واحد مثلي، في عيد ميلاده، بأنه لم يُضرَب كثيرا، أو يعذب بما فيه الكفاية، ويرى في هذا شيئاً من الغرابة، ويفتش عن الأسباب التي جعلته من الفئة الناجية!
بلغتُ الثالثة والثلاثين في عام 1984. وهو رقم أنظر اليه بتهيب كبير ، فهو يمثل لى علامة ثلث قرن، وزحف قليل سينتصف قرن ، وكنت أتخيل دوما أنى لن أستمر بالحياة أكثر منه،
أي أن المصادفة أوقعتني بالضبط تحت برج جورج أورويل. ولمن لا يذكر فقد شهدت تلك السنة عودة إلى الاهتمام بجورج أورويل، وتحديداً بروايته 1984. ولمن لا يذكر أيضاً فإن هذه الرواية صوّرتْ ما يمكن أن تصل إليه بشاعة الأنظمة الأمنية، حين تتحكم في العالم، كتبها أورويل عام 1948، وقلب آخر رقمين على سبيل التنبؤ. أنا واحد من أولئك الملايين الذين لا اسم لهم في رواية أورويل. صدّقوني ليس هذا بالمجاز، بل على العكس. الرواية هي الاختزال والمجاز، فلم يكن لدى أورويل الوقت والصبر ليفرد لي مساحة خاصة. والحق أنه كان مصيباً، إذ لا يمكن الحديث عن أفراد في ظل أنظمة تفعل كل ما بوسعها لتسحق فردانيتهم.
ففي عام 1973 لم تكن البلاد تتسع سوى لصور الرئيس المتدين ، والزعيم المقاتل ، وصاحب العبور! أبناء الجيل الذى جاء بعدنا لم يعوا غيره زعيماً. ففي بداية وعيهم الطفولي، أي في عام 1973، قيل لهم إنه انتصر على أعداء الداخل ، وأنا واحد منهم وسط موكب هادر من طلاب مصر بالجامعات ، ،و عملاء الخارج مراكز القوى فى عهد لم يشارك فيه بأدنى جهد، ومرّغ بالوحل أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر، وبعدها بأربع سنوات تصدى للمؤامرة التي استهدفت خاصرة مصر ، وأنقذ مصر من الخراب والمجاعة، ومن ثم تصدى لخونة الوطن ومشاغبيه من أمثالي ، الذين باعتهم طلائعيتهم الى الغربة والمنافى الإرادية واللآإرادية فى بعض الأحيان .
خلال هذه السنوات لا أذكر عدد المسيرات التي تم سوق الآلاف إليها، هؤلاء التلاميذ, كقطيع. ففي عام 1977 مثلاً كان الملايين من الأطفال أمثال يمنى ابنتى يساقون ليهتفوا لبطل السلام أنور السادات . أنا لم أحب السادات، ربما لأنني سمعت به قبل خيانته، لكن مسيرات تعليم النفاق السمج علمتني أن أكره السادات، وبحسب ظني الآن فإن السادات هو أول شخص كرهته في حياتي. وإني لأتذكر بدقة كيف صنع الإعلام غير الرسمي، والمخيال الشعبي، من شخصية السادات شيطاناً كاملاً، أُسبغتْ صفة القباحة على منظره، وعلى طريقة نطقه، وعلى مجمل أفعاله، ولم يعد يمثّل خصماً سياسياً وحسب، وإنما أصبح يجسد الشر المطلق. وهكذا دخلتُ السياسة من بوابة الكراهية.
فمع بلوغي سن الرجولة، في سنة أورويل كما أسلفت، دخل اليساريون من غير المتحالفين مع السلطة حياتي، وقبلها كانت سلطة السادات تشنّ حربها الوقائية ضد أعدائها المحتملين في الداخل، وتحديداً ضد اليساريين من أصدقائي وغير أصدقائي. شاركت في النشاطات التنظيمية لليسار بالسبعينات فى جامعة الأزهر قبل أن يتم فصلى ، وبعدها بأكاديمية الفنون ، التى تصديت فيها – مساندا من قبل رفاق كثيرين لتخرصات رشاد رشدى وتهويماته الرجعية وأساليبه الأمنية في إدارة شئون ألأكاديمية، وعشت أجواء الفوضى الفكرية التي تتيح تجاور ماركس وفرويد ولينين وتروتسكي وروزا لوكسمبورغ، وطبعاً ولهام رايش في إنجيله "الثورة والثورة الجنسية". وخلال تلك السنوات شاركتُ اليسار في اقتراف الكثير من الأفعال التي اعتقدنا أنها منافية للسلطة، شربنا ما وقع تحت أيدينا من خمر، وعاشرنا ما أُتيح لنا من نساء، حتى أن صديقا أكبر لنا عاشر ساقطة لحظة أن وضع السادات جبهته مصليا فى المسجد الأقصى، وغنينا أغنيات التحدي التي أداها الشيخ إمام، وسهرنا ليالي كثيرة وطويلة ونحن نتدرب على كراهية السلطة. وعلى مدار خمس سنوات انفضّ أصدقائي اليساريون، اعتقل قسم منهم، وهاجر قسم آخر، وتاب بعض منهم، فيما اكتشفت متأخراً ما فعلتْه بي يساريتي، إذ بتُّ أكره، بالإضافة إلى السادات، أمريكا وعملاءها والسلطة ومخبريها، وأكره انتهازية الروس ولا ثوريتهم، وأكره الخيار الثالث وميوعته، زادت كراهيتي للأعلام والأناشيد الوطنية وصور الزعماء، باختصار بتُّ أكره كل ما يعكر نقاء حلمي اليساري. وفي تلك الفترة أحببت فقط الزعيم السوفييتي أندروبوف لأنه مات سريعاً، وكأن نقمتي لم يعد لها رجاء سوى الفناء البيولوجي لسلطات وقوى راسخة لا يزحزحها إلا القدر. ، وباتت كل مدينة عربية على كل حال ألقاها غير راغبة في فتح صدرها لي إلا بقدر ما يسمح به أربابها، لذا وقفت في ميادين كل تلك المدن بدءا من بيروت حتى مكناس بالمغرب مرورا بتونس وصنعاء وتعز ، وكأني لم أقترب من غير شواطئ جغرافياتها ، فحرصت بقسوة على نفسي أن أغزوها رغما عنها ، وأن ابلل الروح بملامح أبنائها ، وكانت تلك العلاقات التي تتناسل كل يوم مع رموز العافية فيها من كتاب وثوار وصعاليك وحفاة ملا حقين وأوباش ومجانين بحب الحياة مثلى ، وكان أن نهشت فطيرة قدمها لي محمد شكري ذات سنة ، وبعدها لم أشعر بجوع للحياة أبدا .
ولكن النقمة أفقدتني مرات الثقة بالآخرين وبنفسي، وفي وقت ما بدأت التغيرات الكبرى في العالم ،كنت قد توقفت عن النمو النفسي والعاطفي. انهارت الكتلة الشرقية وبقي الكثير مما أكره، وهذا لم يُحدث فرقاً كبيراً لأبناء جيلي العاطلين عن الحياة في بلد لا يزال منتمياً إلى 1984، ويحكمه الأفول البريجنيفي شديد البطء. عندما لا يتغير شيء في حياتك فلا شيء حينها يثبت أن الزمن يمر، هذا الإحساس يصبح حقيقة واقعة. فالكتاب من أبناء جيلي ظلوا خلال عشرين سنة وهم يُشار إليهم على أنهم شبّان واعدون، أسوة بأقرانهم من الفنانين أو أصحاب الكفاءات العلمية أو غيرهم. إن حياة أبناء جيلي من المصريين تساوي ولاية أبدية لرئيس راحل مضافاً إليها، بالاستمرارية ذاتها، جزء من ولاية رئيس لاحق. أليس هذا مبرراً كافياً لنكون أولاداً على أبواب الأربعين؟ هذا طبعاً إذا غضضنا النظر عن مقدار ما في حياتنا من حياة. ففي زعمي، نحن أكثر شعب تفترب أعماره النفسية عن أعماره البيولوجية، وعلى هذا ربما يكون من العدل الإلهي أن نُمنح أعماراً مضاعفة على ألا تُمنح هذه الفرصة لقادتنا، أو أن تُحسب أعمارنا بقدر ما نغير من أنظمة. يلزمنا الكثير من الوقت لتصبح حياتنا شبيهة بحياة الآخرين، وبحساب الولايات الرئاسية السابق فإن متوسط أعمارنا يجب أن لا يقل عن ثلاثمائة عام، ليعادل سبعين عاماً لمواطن غربي، وحينها ربما استطاع كتابنا الشباب أن يصبحوا رجالاً، وربما أنجز مخرجونا السينمائيون أفلامهم المؤجلة والمعطلة، وحتى نساءنا المقيمات ربما تحولن حينها إلى عابرات جميلات.
إن الحصيلة المرّة لحياتي تكاد تتلخص بالملل، فما زلت أكره الأشياء ذاتها: أكره السلطة، وأكره رجال الأمن حتى في أفلام السينما، وحتى إن أدت هذا الدور حسناء مثل أنجلينا جولي. ذهب السوفييت ولم آسف على ذهابهم، ولم يقدم لي الأمريكان مبررات مقنعة لأحبهم، وعلى العموم أتمنى الحصول على مبررات مقنعة لأحب أي شيء، لعلني بهذا أتخلص من وحش الكراهية الذي حملته طويلاً. لكن لم يتبقَّ لي من الوقت ما يكفي لأقايض أوهاماً بأوهام، ليثبت لي أحد أن لي فرصة حقيقية للعيش في هذه البلاد، وقد رحل الرفاق الحميمين ونادية زهرة الروح السليبة قضت في قبوها المظلم أيام السادات ،وأنا مللت العيش في السماجة والرتابة. ليثبت لي أحد صحة جملة من نشيد وطني، أو جدوى شعار من الشعارات، والشعارات المعارضة لها أو المزايدة عليها، التي أفقرت حياتي، وإلا كُفُّوا عن استغفالي على هذا النحو الرديء، ابتكروا طريقة جديدة لسرقة ما تبقى من عمري. إن يأسي لا يدفعني إلى أبعد من المطالبة بالتحول من مغفل مهان إلى مغفل محترم.
يقول لي صديق بترف أحسده عليه: ألا تلاحظ أن أبناء جيلنا بدأوا يعانون أزمة منتصف العمر؟ أما أنا فأفكر: ما أصعب أن تعيش أزمة منتصف العمر في بلد لم يكن لك فيه عمر. فقياساً على ماانصرم من عمري لا أعتقد أن لي فرصة جيدة في الحياة، حتى وإن حدثت بعض التغييرات فثمارها ستكون من نصيب أجيال لاحقة، أما أنا ففرصتي الوحيدة الآن هي أن أعد العدة لزيارة قبر ابنى متمنيا على الله تحقيق تلك الأمنية السوداء ، وأن اقوى على كتابته فى الغد ثم أرحل إليه ، وثمة فرصة اخرى ، وهى أن أفتح النافذة، فأرى جيراني يؤرجحون بقرتهم، على نحو ما يحدث في إعلان عن الزبدة، وأتأكد من أنني مواطن عربي حلم حلماً مزعجاً بأنه عاش كمصري أو عربي، فأبتسم وأهزّ رأسي، وأقول لنفسي برضا وثقة: لقد كانت ليلة فظيعة، لكنه كان كابوساً، كان كابوساً وحسب.
magedhiem@hotmail.com
magedhiem2007@yahoo.com











.jpg)













































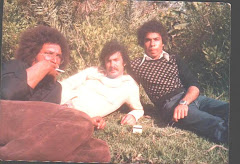













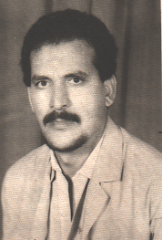









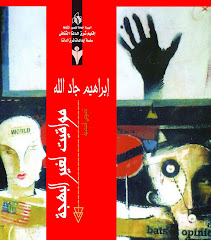

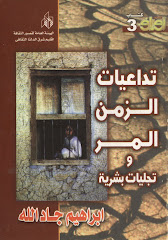









.png)









-001.jpg)











ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق